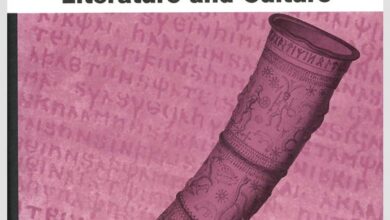إنَّ القراءة لبلوم تشبه تسلَّقَ جبلٍ للقاء مُتنسكٍ والاقتباس من فيوضه النورانية وأقواله العرفانيّة.
هذا أول ما دوَّنته بعد أن أكملت كتاب بلوم “التقليد الأدبي الغربي”، وهو كتاب نقدي تناولَ بالدراسة أدب ستةً وعشرين كاتبًا منذ دانتي أليغييري الإيطالي إلى صمويل بيكيت الأيرلندي، وكان القلب النابضُ لهذا الكتاب شيكسبير بمسرحياته وتأثيره الممتد في الأدب الإنساني منذ أن مُثِّلت ونشرت مسرحياته. نُشرَ الكتاب بنسخته الإنجليزية عام 1994، حين ناهز بلوم الرابعة والستين من العمر، وهو أبرز كتبه التي نافت على العشرات في النقد الأدبي. يحلو لنا، ولبلوم بلا شك، أن يُلقَّب بحارسِ التقليد، والمنافح عنه ضد من أسماهم “مدرسة التذمَّر” وخصَّ بها التفكيكيين، والنسويين، والتاريخانيين الجدد، وكلَّ من يحاول بدعوى التعددية الثقافية والآخر الحطّ من الأدب الرفيع، وتجاهله أو التعسُّف في قراءته “محاكمته”. بلغَ بلوم في آخر حياته، توفي عام 2019، ذرى الشهرة فعُرفَ بأنه أشهر ناقدٍ أدبي في العالم الناطق بالإنجليزية. وليس هذا اللقب عن فراغ، فالقراءة لبلوم أو السياحة معه، تجعلكَ موقنًا تمام اليقين أنَّك في حضرة قارئ بارعٍ وناقد حصيف وأديب لبيب. يُقدِّم في هذا الكتاب النقدي موسوعة معرفيّة قائمة على شبكة من التواصلات بين الأدباء وكُتبهم ومواضيعهم، فتصبحُ القراءة له بعد عدة صفحة ولوجًا لمتاهة لا يسعك إلا التشبُّثَ بأذياله حتى لا تضيعَ فيها. إنَّ العقلية الفذَّة التي يقرأ بها بلوم النصوص لا تُنيرُ البقعَ المظلمة في النصوص بل تأخذ بيد القارئ إلى ما وراء النور والظلمة، إلى حيث يقف على منابع النور ومجاهل الظلام في كلِّ نصٍ، مستوفيًا في قراءته استيفاءً يحضُّكَ على إعادة قراءة النص إن كنتَ قرأته من قبل، أو دفعكَ إلى قراءته دفعًا دون أن تجد لنفسك بُدًا من ذاك. لا يطمحُ في كتابه هذا إلى شيءٍ سوى أن يربطَ القارئ الجاد بالأدب الرفيع في زمن تهافتَ فيه الأدب، ومدَّ تخومه إلى عوالم الفوضى والإسفاف، وخضعَ إلى الأجندة الاجتماعية والسياسيّة فاقدًا بريقه وأصالته الإبداعية وحريَّته الفكريّة ومتانته اللغوية، كانت في السابق الأسسَ التي يحجزُ فيها النصُّ الأدبي موضعه في التقليد، ويرسِّخُ مكانه بتعاهد قراءته في العقود اللاحقة من القرَّاء والنقَّاد على حدٍ سواء، ويتواصل تأثيره في الأدباء، الذين وإن حاولوا التخلَّصَ أو نفي التأثير أثبتوا ذلك كما الحال لدى إبسن وميلتون وتأثرهم الجلي والخفي بمركزِ التقليد، شيكسبير. لم يقتصر هذا المركزِ على شيكسبير، وإن كان تغنِّي بلوم به يكشف عن ثقله الأكبر فيه، إذ صاحبه في المركز الإيطالي دانتي بقصيدته الخالدة “الكوميديا الإلهية”. أما السبب الذي يمنح هذين المركزَ فيعلل بلوم اختياره لـ”الطاقة اللغوية، والرهافة المعرفية، وقوة الخلق”. لو حلَّلنا هذه العناصر الثلاثة في قوله لوجدنا فيها الفحوى المنهجية التي يؤسس وفقها بلوم قراءاته ونقده. إنَّ الطاقة اللغويّة مقصود بها، في المقام الأول، اللغةَ وقوَّتَها وبلاغتَها، وما يُمكن للأديب أن يفعله باللغة بأخذها إلى أقصى حدودها وإمكانيات ألفاظها والمعاني المتأتِّية عنها، وهذا ما نجده لدى شيكسبير، الذي لا يرى بلوم أنَّ كتبَ الإنسان بل خلقَ الإنسان، فمسرحيات شيكسبير بلغتها البارعة تمكَّنت تجاوز حدود الممكن وحازت على قوة الخلق. وقوَّة الخلق تُشيرُ إلى معنى الإبداع والتعامل مع الموضوع الإنسانيّ والكونيّ بالوسائل التي تحفظُ الصلة مع السابق وتبنيها مع اللاحق، لكنها تبقى محتفظة بأصالتها وفرادتها، فالرابطُ الوجوديّ والإبداعي بين نصٍ سابق ولاحق لا يلغي بل يُعيد قراءة ويُكمل ويبزُّ وأحيانا يتفرَّدُ بالاتباع والتأثر. تنبثقُ المعرفةُ من طاقة اللغة وقوة الخلق المُتناسجين معًا في عرض الإنساني والكونيّ في سهولةٍ ويسرٍ، لكنَّها لتحتفظَ بقدرها وعدم الانحطاط فهي ليست في متناول الجميع. إنَّ الرهافة المعرفيّة، هالةُ من الإدراك البشريّ للذات والعالم تُحيط بالنصِّ وتتغلغل فيه، وتخلقُ نفسها بنفسها بمرور الوقت وتعدد القراءات، فهي نصوصُ في حالة نموٍ مستمرٍ في ذات المجال اللفظي التي نشأت فيه، بيد أنَّ مراميها تختلف وتتنوع لارتباطها بذات بشرية متناميّة ومتغيَّرة. لا يتمتَّع أيُّ نصٍ بهذه المقدرة العالية في الإبداع غير المنقطع والنشأة المستمرة المتكاملة، لذا كان لا بد من إبراز النصوص التي تمتعت بالأصالة، واستطاعت تجاوز الزمان والإنسان، وأن تمنح المتلقّي شعورَ العجب والجدَّة دائمًا. أي أنها نصوص غير محدودة في مكان أو زمان أو لغة، تنبعُ فوَّارة صافيّة في كلّ لغة، لأنَّها تحمل مكامن قوَّتها في ذاتها. وليس من تعارضٍ ازدهارها في لغة تستعصي على أخرى أن تحتضن فرادتها، لكن الفكر الذي يخاطبُ العقول المتباينة اللغات يضمنُ لها التميُّز والمراتب العالية عند كلَّ قراءة في أيّ لغة.
حرثَ بلوم في نصوص السابقين على مدار السنين، وخرجَ بغَلَّةٍ لا تقل فرادة عن النصوص الإبداعية التي ارتكزت كتابه عليها، لكننا قُبالة نصٍّ نقديّ هو بلا شكٍ جزءٌ من التقليد الغربي، وامتدادٌ للناقد صمويل جونسون، الذي أفردَ له بلوم فصلًا في كتابه، فالنقدُ الأدبي يحتَّلُ موضعًا لا غنى في التقليد الأدبي، لأنه يعلِّمنا كيف نقرأ ونفهم النصّ. وجونسون هو قارئ كاتب علَّم بلوم كيف يقرأ. لا يبني بلوم في كتابه بانثيونَ التقليد الأدبي الغربي فقط، بل ويبني نفسه ضمن البانثيون ناقدًا للتقليد، وحارسًا له. وينطبقُ فيه قول أدونيس:
آيتي أنني منهم- بشر مثلهم
ولكنني أستيضيءُ بما يتخطى الضياء، آيتي أنهم
يقرأون الحروفَ، وأقرأ ما في الخفاء
إنْ قصرُ مجهودُ بلوم على تعليمنا كيف نقرأ لكفاه وأرضاه، فما كتابه هذا إلا دليلَ قراءة لأولئك القرَّاء الذين ما زالوا في منأى عن لوثة العالم المعاصر وقراءاته الملطَّخة بالهراء الفكري والتعدديّ والتقبُّلي المنفلت والفوضويّ. لا يقتصر النقد عن بلوم على نوعٍ أدبي دون آخر فهو ينقدُ عناوين مختلفة في النثر والشعر والمسرح والرواية، لذا يجد القارئ نفسه في حضرة قامة أدبيّة نقديّة عملاقة، وشخصيّة قارئة موسوعيّة متَّقدة الذاكرة والفكر. لا يغيبُ عن ذهن القارئ عند القراءة اقتران التقليد عند بلوم بشيكسبير، ولا سيما مسرحياته الأشهر: هاملت، ماكبث، عطيل، الملك لير. شيكسبير هو مركز نقد التقليد عند بلوم، فدراسته لأدباء ما بعد حقبة شيكسبير مرتبطون على الدوام بشيكسبير، فيُلاحظُ ظلَّ المسرحيّ مخيَّما على الأدباء الغربيين من بعده وتأثيره في نصوصهم، وهو بذلك ينسجُ شبكة متداخلة ومنفصلة في الآن نفسه، مركزها شيكسبير، فهو كالشمس للكواكب، يشغل واسطة عقد التقليد الأدبي. ولهذه الترابط بين النصوص والتراتب في نقد التقليد عند بلوم أهمية في تبيين أنَّ التقليد الغربي، بتنوعه الأسلوبي واللغوي والصنفيّ وتباينه، هو كتلة واحدة متراصَّة ومتعشِّقة، أيَّ أنه نتاج أمة كبيرة تضم داخلها أممًا أخرى أصغر، فالتقليد الأدبي الغربي، الأوروبي والأمريكي الشماليّ والجنوبيّ، هو أدب واحد في الأساس، والاختلاف الداخلي منضوٍ فيه لا خارج عنه. لكن ما مدى صحَّة هذا المفهوم الذي يظهر في اختيارات بلوم للأدباء والكتب ولا يصرِّح به، فما الذي يربط أدب أمريكا الجنوبيّة بالأدب الأوروبي، وما السمات المشتركة بين الآداب الأوروبيّة التي تجعلها أدبًا واحدًا رغم تمايزه اللغوي والأسلوبي؟ هذه أسئلة لا يُجاب عنها في الكتاب، وتبدو منبثقة من المركزيّة الغربيّة المتمثلة في أوروبا وأمريكا الشماليّة والجنوبيّة مع أن الاختلاف موجود، فلو حسبنا أمريكا امتدادٌ لأوروبا، فما الذي يربط بين أمريكا الجنوبيّة وأوروبا سوى اللغة الإسبانيّة والبرتغال، لغة المستعمر القديم إسبانيا والبرتغال، والمسيحيّة. إنَّ توضيح الأسس التي جعلت الأدب الأوروبيّ الأمريكيّ الشماليّ والأمريكيّ الجنوبيّ أدبًا واحدًا ضرورةً في فهم تقسيم العالم الأدبي، واندماج أقسامه أو انفصالها، بيد أنَّ بلوم لم يسلط الضوء، ولربما لم يكن في حسبانه من الأساس طرح هذه المسألة. لكن القارئ من خارج أمم التقليد الغربي، ستخطر في ذهنه هذه الأسئلة، ويعود به الفكر إلى المنطلقات التصنيفيّة، التي تجعل أدب هذه الأمة ينخرط ضمن التقليد الغربي من عدمه.
ختامًا، توزَّع كتاب التقليد في أربعة أجزاء عنوَّنها بالعصر الأرستقراطي ابتداءً من دانتي، وتشوسر، وسرفانتس، مرورًا بمونتان، وموليير، وشيكسبير، وميتلون، وصمويل جونسون، انتهاءًا بفاوست. ثم العصر الديمقراطي ابتداءً بوردزورث، وأوستن، وويتمان، وإميلي ديكنسون، مرورًا بديكنز، وجورج إليوت، وتولستوي، انتهاءً بإبسن. ويبدأ العصر الرابع بفرويد، وبروست، وجويس، مرورًا بفرجينيا وولف، وكافكا، وبورخيس، ونيرودا، وبيسوا، انتهاء بصمويل بيكيت. ويردفُ الكتابَ بملحقٍ يضمُ مئات المقترحات للقراءة من كتب التقليد الأدبي على وجه الخصوص، وبعض العناوين من خارج التقليد الغربي.