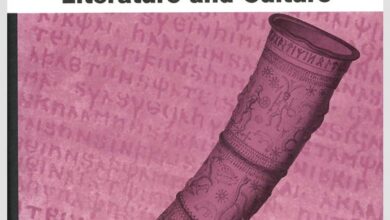النقد الأدبي الحديث – الدكتور محمد غنيمي هلال

هذا الكتاب بحث أدبي نقدي ضخم يُقارب السبعمائة صفحة، هو تتبع واستعراض تاريخي للنقد الأدبي منذ عصر اليونان الإغريق حتى العصر الحديث في النصف الأول من القرن العشرين، متناولا الأدب بكل صنوفه الرئيسة (مسرحا وشعرا وقصة)، ومستعرضا أشهر النقاد الأدبيين وآرائهم في المسرح ومواضيعه وعناصره الفنية والشعر وموسيقاه وإيقاعاته وأوزانه ولغته، والقصة -سأشرح في السطور التالية الخلل في اختيار هذه التسمية- وعناصرها الفنية والأسلوبية والموضوعية. انطلاقا من أفلاطون وأرسطو يبتدئ هذا الكتاب رحلته التتبعية للنقد الأدبي انتهاءً بأحدث المدارس النقدية الحديثة وتأثيراتها في الأدب وسيرورته.
الكتاب مقسم إلى ثلاثة أبواب رئيسة تتفرع منها الفصول. الباب الأول تناول النقد اليوناني متمثلا بأفلاطون والجزء الأكبر بأرسطو وآرائه في الشعر والمسرح والملهاة والمأساة والملحمة والخطابة، والتفصيل والاستفاضة في هذه المواضيع يبلغ من الاتساع والأهمية والطرح المزود بالأمثلة والهوامش ثريا جدا، وابتداءً من المحاكاة التي يعرفها أرسطو بـأنها ليست رواية الأمور كما وقعت فعلا، بل رواية ما يمكن أن يقع، وهذا مجال الخلق الفني والتوجيه الاجتماعي، وهو الفرق بين المؤرخ والشاعر. فالمؤرخ ينقل أشياء وقعت فعلا. والشاعر يحكي أشياء من بُنيات أفكاره. ويحصر طرق المحاكاة في ثلاثة أمور “ما دام الشاعر محاكيا- شأنه شأن الرسام وكل فنان يصوغ صورة-:
1- يصور الشاعر الأشياء كما كانت أو كما هي أولا. وينبغي أن يراعي الشاعر نماذج الواقع ليكشف عما يريد من وراء تصويره للواقع إكمال له.
2- أن يصور الشاعر الأشياء أو الأشخاص كما يراهم الناس ويعتقدون فيهم.
3- أن يصور الشاعر الأشخاص كما يجب أن يكونوا.
أما الشعر فمفهومه عند أرسطو ينحصر في المحاكاة، أي أن تمثل أفعال الناس ما بين خيرة وشريرة، حتى تكون مرتبة الأجزاء على نحو يعطيها طابع الضرورة أو طابع الاحتمال في تولّد بعضها من بعض. والشعر الحق عند أرسطو يتجلى في المأساة والملحمة والملهاة. والمحاكاة لا الأوزان هي التي تفرق بين الشعر والنثر. فإذا نظم امرؤ حقائق تاريخ أو نظرية في الطب، أو الطبيعة فإنه يسمى عادة شاعرا، والحقيقة أنه ليس بشاعر. وتأخذ الملهاة والمأساة والملحمة حيزا من فصول الباب الأول لأهمية هذه الأنواع الأدبية التي كانت رائجة وقتها، مختتما الفصول بالحديث عن الخطابة عن اليونان. والخطابة عند أرسطو ثلاثة أنواع: الاستدلالية والقضائية والاستشارية. ولا يكتفي بالطرح التاريخي والأمثال والنقد الذي قاله أرسطو وخط أسسه في الأدب الأغريقي بل ومقابلة أقواله مع أقوال أفلاطون.
يتناول الباب الثاني من الكتاب، النقد عند العرب، والنقد في هذا الموضوع يتناول الشعر فقط، واستعراض المواضيع الشعرية التي كانت ترد في أشعار العرب، والأساليب النقدية سواء في عصر ما قبل الإسلام وشعرائه الكبار أو العصور اللاحقة وطرح الأفكار والمناهج النقدية المختلفة ما بين علماء اللغة وكبار الشعراء في اختيار الجيد من الشعر دون سواه كالجاحظ وابن قتيبة وبشار بن البرد والأصمعي، وعبد القاهر الجرجاني صاحب النظم (علم التراكيب). تتنوع فصول هذا الباب ما بين الأجناس الأدبية شعرا ونثرا، لكن النثر يأخذ الخطابة فقط، وفي هذا قصور واضح إذ للعرب إرثهم القصصي والذي كان من المفترض ذكره بدل الاستمرار في منهج التهميش الاستشراقي في نفي أي إرث عربي نثري قصصي معتبر، وسنشاهد هذا القصور واضحا في الباب الثالث في موضوع القصة عند العرب. وتتناول الفصول الأخرى القول عند العرب وأجزاء القصيدة والوحدة الموضوعية والأهداف، والوجوه البلاغة، ويختم بالفصل الأخير والبحث في موضوع اللفظ والمعنى والانقسام الذي شهده النقاد العرب بين ما مالَ نحو جمال المعنى دون الاهتمام كثيرا نحو اللفظ أو ما مال جمال اللفظ دون اهتمام كثير بالمعنى، حتى وصل الأمر نحو إمام البلاغة العربية عبد القاهر الجرجاني ونظريته في النظم والصورة الأدبية، خاصة في كتابة أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز.
الباب الثالث، الأخير، من هذا الكتاب فتمثل بالنقد الأدبي الحديث والذي شهد البدايات في نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر، ويفتتح الباب بالحديث عن أسس الجمال الفلسفية واستعراض لمناهج فلاسفة كـ(ديدرو وكانت وهيجل وكروتشيه) وآرائهم في مفهوم الجمال في العمل الأدبي والفني وكيفية الحكم على العمل وإدراك قيمه الجمالية، وما منابع هذا الجمال في العمل الفني، ويتبع باستعراض المدارس النقدية كالمدارس الأمريكية (التصويرية والنزعة الإنسانية) والمدرسة التأثيرية في نتيجة للفلسفة الجمالية المثالية، والانتقال للحديث عن الفلسفات الواقعية والاشتراكية والوجودية والرمزية في الأدب. الفصل الثاني من الباب الثالث يتحدث عن الشعر وتتبع نشأة الشعر ومواضيع الإلهام الشعري، وشعر الحركة الكلاسيكية والرومانتيكية. ومفهوم الشعر في العصر الحديث الذي اختلف عن مفهومه قديما هذا ما يخص الشعر الغربي في مواضيع التجربة الشعرية والوحدة العضوية والصياغة وموسيقى الشعر، لكن الشعر العربي بقي محافظا على بحوره وإن اختلف في بعض المفاهيم كوحدة العضوية للقصيدة والقالب القديم لها، ولم يتناول الكتاب حركة التجديد التي تمثلت بالشعر المنثور وقصيدة النثر إذ يراها الكاتب وللعجب بأنها غير ذات تأثير وأهمية! رغم حداثة الكتاب. أما الفصل الثالث، فتناول موضوع القصة في الأدب، وهنا الكاتب لم يوضح الفرق بين القصة والرواية، إذ جعل الاثنين صنفا واحدا، وهذا ما سيجده القارئ عند القراءة، فعلى الرغم من تتبع نشأة القصة والتي تمثلت عند اليونان بالملاحم وظهور بعض الأعمال كالحمار الذهبي لـلوكيوس ثم ظهور المحاولات النثرية في أوروبا بعد عصور النهضة والتي تمثلت في الرواية الفروسية والرعوية والشطارية -رواية العادات والتقاليد- وهنا تبرز نقطة الضعف، والتي أضع عليها علامة استفهام كبيرة، هو تسمية الرواية التي اختلفت الآراء حول بدايتها ولكن ما يتفق عليها بأن عمل سرفانتس دون كيخوته بأنه من الأعمال الروائية الأولى التي ظهرت في أوربا، لكن الكاتب يتناولها على أنها قصة! وكان يجب عليه التفريق وتناول موضوع تطور مفهوم القصة واختلافه عن مفهوم الرواية التي هي أكبر في القصة وتتنوع أحداثها وشخصياتها وتتوزع زوايا الأحداث على آفاق متعددة عكس القصة، وهي في بنيتها أقل تعقيدا من الرواية، لكنه يسمي الرواية قصة، وهذا ما يُلبس على المستجد في هذا الميدان، ولا ينفع الباحث كثيرا إذ شهدت المصطلحات والمفاهيم في الأدب تطورا كبيرا خاصة في مجال الرواية كما في تيار الحداثي وتيار ما بعد الحداثة كان من المفترض أن يكون كاتبه أكثر مواكبة خاصة وأنه نشره عام 1986. على أي حال فإن تناول القصة/ الرواية كان استعراضا ليس نقديا وتتبعيا في تطور البنية وصنعة الرواية بل كان نقديا فيما يخص المواضيع والشخصيات والتأثيرات التي طالتها الرواية من المدارس الواقعية والرومانتيكية والوجودية والرمزية. النقطة السلبية الأخرى هو القصة عند العرب، فالكاتب ينفي القصة عن العرب وحصرها في المقامات ورسالة الغفران وحي بن يقضان هذا فيما يخص الأدب الأصيل، وأما الأدب المترجم فتمثل بكليلة ودمنة وألف ليلة وليلة. وهنا ثمة نقاط:
أولا: القصور في دراسة تطور الفن القصصي عند العربي وقد عرف العرب القصص والأساطير، التي كان يجب عليه تتبعها وذكرها كما في كتاب التيجان في ملوك حمير ويجمع ابن هشام هذه القصص في كتاب التيجان في ملوك حمير، وهي قصص يرويها وهب بن منبه، وهي تمثل حركة التجميع الأولى. وحركة التجميع الثانية كانت مع عبيد بن شرية ومسامراته مع الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان الذي اهتم بالقصص، وكتاب عبيد بن شرية في أخبار ملوك حمير، وتمتاز قصص عبيد بن شرية بردف القصص والأحداث بالأبيات الشعرية، حتى بلغت قرابة سبعمئة بيت شعري في قصصه. وأما المرحلة الثالثة فتمثلت بكتب السيرة التي ابتدأت بسيرة ابن إسحاق التي تناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحال العرب قبله وبعده ومغازيه والحوادث التي حصلت له في حياته. ولفاروق خورشيد كتاب الرواية العربية في عصر التجميع يتناول هذا الموضوع بالتفصيل.
ثانيا: نسبة ألف ليلة وليلة إلى الأدب المترجم، على الرغم من أنها قد اختلفت الآراء حول مصادرها ما بين عربية وفارسية وهندية، والقول بأنها مترجمة دون التفصيل أو التعليل لهو أمر لا يُفهم ولا يتناسب مع بحث كبير ودراسة مهمة كهذه!
ثالثا: عدم تناول المقامة بالصورة الكافية بل استعراضها بإيجاز قاصر بأقل من صفحة على الرغم من أهميتها ومكانتها في النثر العربي.
يعود بعدها إلى مفهوم الحكاية في القصة/ الرواية، والعناصر الفنية في طرح الحكاية في القصة/الرواية. والشخصيات وتنوعها والتركيبة النفسية لها. يشهد الفصل الأخير من الباب الثالث والحديث عن المسرح العالمي وتطوره من اليونان حتى العصر الحديث في القرن العشرين، وقسِّمت مواضيعها إلى موت المأساة ونشأة الدراما الحديثة، الحكاية – الحدث، الشخصيات – الإبداع – الصراع، الموقف الدرامي ومسرحيات المواقف، الفكرة وصراع الأفكار، الحوار والأسلوب.
في النهاية لا يسعنى إلا أن أثني على هذا البحث الثري والكبير والمهم، ومما يبدو واضحا، أن الكاتب ذو نظرة ثاقبة وفكر متقد في تناول الأنواع الأدبية وربطها مع بعضها دون إهمال الجانب الفلسفي، ألا أن أضعف أقسام الكتاب كان قسم القصة والذي حين نقابله بالمسرح والشعر، نجد الفرق كبير سواء في تناول العناصر الفنية لكل فن ومدارسه وصنعتها وتطورها، حيث يفرق ويتفوق المستوى النقدي والتتبعي للمسرح والشعر على القصة بصورة لافته للانتباه، ولا يمكن تلافيها.