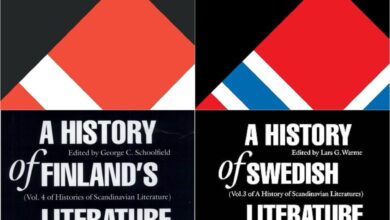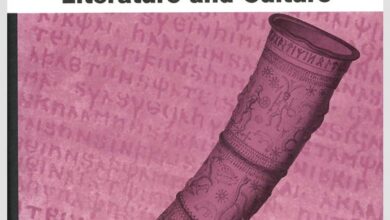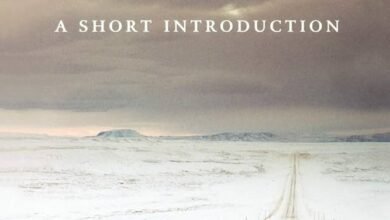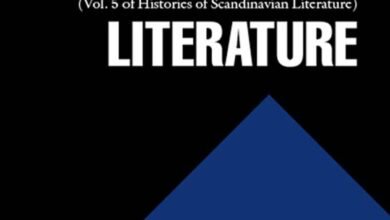الثابت والمتحول – أدونيس
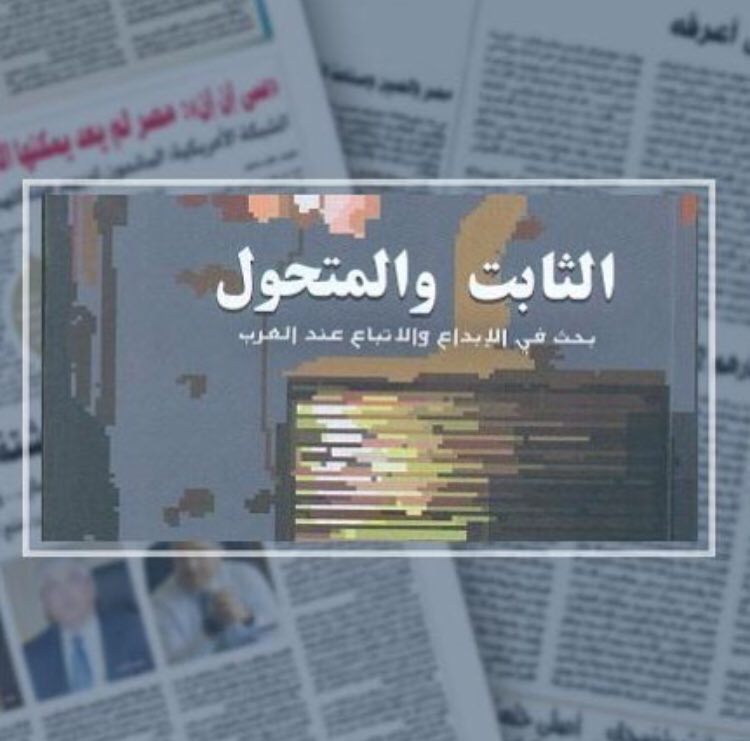
لتحميل القراءة
تحميلالثابت والمتحول
بحث في الاتباع والإبداع عند العرب
هذا الكتاب، المنشور في أربعة أجزاء للشاعر السوري أدونيس، في الأصل رسالة تقدم بها أدونيس إلى جامعة القديس يوسف ببيروت لنيل شهادة الدكتوراة في الأدب العربي. في الصفحات التالية قراءة في كتاب الثابت والمتحول، واستعراض لما جاء فيه.
الكتاب الأول: الاتباع والإبداع
يقدم أدونيس في هذا الكتاب موضوعا جدليا ومؤثرا في مسار المجتمع العربي الإسلامي، بعد الرسالة المحمدية، في إطار السياسة والدين وتأثيرهما في مسار الأدب العربي الشعر، ويقسم بحثه أو كتابه قسمين هما المحوران الرئيسان: الاتباع والإبداع. ينطلق من الاتباع في الأدب ورابطا إياه بمفهوم الاتباع الديني -العقائدي المتمثل بتعاليم الإسلام، والسياسي المتمثل بالخلافة-. فيبدأ بدور العقيدة الإسلامية وتحكّمها في مواضيع الشعر ودلائله وأغراضه، منذ النبي محمد نزولًا لأصحابه والخلفاء، حيث حُكم على الشعر بمواضيعه وأغراضه، فمدحوا ما يتوافق مع رسالة الإسلام وأثنوا على شعرائه، وذموا ما خرج عن قيم الإسلام وأخلاقياته وذموا أصحابه، ووصلت في مواقف شتى إلى القصاص من شعراء، لا سيما من هجوا النبي أو من كتبوا في المحرمات. أما السياسة فقد استخدمت الشعر أداةً للإعلام الذي يصب في خدمة السلطة والحاكم، وهذا ما كان واضحا في عهد الأمويين، إذ أصبح الشعر وسيلة للشعراء لدعم السلطة في سياستها، ومصدرا لارتزاقهم بمواضيع شعرهم ومدحهم الأمراء. وينطلق الاتباع السياسي من خلافة النبي ومبايعة الناس للمهاجرين بخلافة أبي بكر ثم عمر وعثمان وعلي، رغم اعتراض الأنصار ورغبتهم فيها. كانت سياسة هؤلاء اتباع نهج النبي في الحكم، وكذا في باقي جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية، وإحداها الشعر بمواضيعه، وبقيت ذات المعايير تحكم على الشعر منذ حقبة ما قبل الإسلام عند العرب، مع فارق نوع المواضيع الذي يخدم مصلحة الدين والدولة.
يربط أدونيس ما بين الاتباع الديني والاتباع الشعري، وبما أن الدين موروث ثابت وأصيل غير محدود بزمن، متجدد دائما لا يبليه عصرٌ ولا زمان، أبدي خالد، ولأنه نزل باللغة العربية متمثلا بالقرآن الكريم، أولَ مصدر للتشريع، وهي لغة قريش، أصبح الشعر الجاهلي مرتبطا بالدين الذي رفعت رايته الخلافة التي تمثلت بقريش. يأخذ الشعر من الدين صفة التجدد الدائم والكمال المطلق، وأن أفضل الشعراء هم الأوائل وكل من يأتي بعدهم هو بمرتبة أدنى، وعليه أن يلتزم بالماضي، كونه هو الكمال للشعر، والقالب الذي لا يجب أن يحيد عنه. والشاعر مهما كان عصره وزمانه، سيكون مجبورا على العودة إلى الوراء، فالكمال يقبع خلفه لا أمامه، والمستقبل الشعري، كان في الماضي وبقي هناك، وبمرور الزمن يبقى هو النور الخالد في الحاضر والمستقبل، وإن أردت الكمال فعليك العودة إلى الوراء وليس التقدم إلى الأمام. اكتسب الشعر هذه الميزة لارتباطه بالدين والعقيدة الدينية الثابتة والكاملة في كل العصور. هذه نقطة جوهرية، إذ صار الشعر مؤطرًا بإطار قُدسي، لا يُعّدل ولا يُرمّم وكل محاولة للخروج عن المسار الذي وضعه الأوائل -شعراء الجاهلية- هي محاولة في الثورة على الأصيل، وستبوء بالفشل، فالجديد لا يتجدد والخالد لا يموت، والكامل لا يكتمل، وأصبحت أي محاولة تجديد غير مجدية لأنه يُحكم عليها من قبل النُقّاد بأحكام الشعر المتعاهد عليها، ولا يُمكن الاحتكام إلى أحكام جديدة لا بد أن تثبت قواعدها أولا، ولا قواعد إلا بقوالب الشعر القديم. تتراءى المسألة هنا أقرب إلى اللغز منها إلى محاولة التجديد، لأنه لا يُمكن لأي تجديد أن يرى النور إلا في حدود القديم، ولا يمكن للجديد أن يبني أحكامه بذاته، إلا إذا ارتبط بالقديم الذي لا يسمح له بالتغيير فيبقى حبيسا له أبد الدهر.
أما الإبداع فهو كذلك مرتبط سياسيا ودينيا، واتّخذ هذا الارتباط قاعدةً انطلق منها رغبةً في التغيير. يستشهد هنا أدونيس بحركة الخوارج، وخروجهم على الخليفة عثمان بن عفان، بسبب فساد من ولّاهم على الأمصار وعدم معاقبته لهم وعزله للفاسدين، ومن ثم تمثّلت بالتعارض بين علي ومعاوية، وكل الحركات السياسية والثورية التي شهدتها تلك المدة على نظام السلطة العام، من أجل تصحيح الأوضاع وتعديلها، وعزل الولاة الذي سرقوا مال العباد باسم الله، وظهور رغبة في الخروج على المتعارف عليه، والمقدس، الذي أخذ قدسيته من الدين -وهنا اقصد الخلافة-. يناقش أدونيس مفهوم الخلافة والملوكية والإمامة -عند الشيعة- ليضع الأمر على حجر اختبار بين هذه المفاهيم الثلاثة وكيفية الخروج والتغيير، اللذين ينبعان من مفهوم الإبداع، والتحرر من المتوارث، وبظهور هذه الحركات السياسية، ظهر الإبداع الشعري، وهنا خروجه عن مواضيعه التقليدية، ليعبر عن أهداف هؤلاء -واجهة إعلامية- التي صدحوا بها ضد النظام الفاسد، وفق إيمانهم. لكن الخروج عن المألوف في شعر العرب لم يبتدئ بالخروج عن الموروث من خلال الحركات السياسية والثورية على السلطة، فقد كان خروج امرئ القيس بشعره البداية في استحداث مواضيع جديدة، كانت تتمايز عن المتعارف عليه، حتى اضطرت أباه إلى طرده لأسباب أخلاقية واجتماعية تمثّلت في شعره وأغراضه، وكما وُصف (تعهّر بشعره)، وكذلك في معايير النقد الشعري السائد آنئذ، كالقياس من الواقع، ودنوِّ الهمة، التي تعارض كون امرئ القيس ملكا وابن ملوك، والوصفِ لفرسه الذي أراد به مدحا لكنّ أوصافه تُظهره ذا نقصية لا مزية، وهذا ما لم يعهده العرب في شعرهم.
ينتهي الكتاب الأول بشعر جميل بثينة، ونظرته إلى المرأة، وتغير مفهوم المرأة ما بين السابق وبين ما وصفه جميل وبيّنه وعاشه. تمثل بثينة لجميل الأنثى الخالدة التي لا تكبر ولا يصيبها الدهر بآفاته، فهي كالنار التي تضطرم في صدر جميل فتُبقي حبه لها ملتهبا وتؤذيه في ذات الوقت. تغيّرت النظرة إلى المرأة مع جميل عن المنحى الذي كانت تُوصف به في شعر الأقدمين، وهذا التجديد نقلة فريدة في الخروج عن المألوف والإبداع في الشعر. يقابله أدونيس بامرئ القيس، فشعر امرئ القيس عن المرأة يمثل نزوة جسد وضرورة يومية، على العكس من جميل بحبٍ عفيفٍ بعيدا عن ملذات الجسد، وليس حاجة يومية تنقضي، بل حاجة سامية وخالدة، أزلية وأبدية، تمثل اتحاده بالكون والموجودات، بنظرة فلسفية وصوفية، فقيمتها ودوافعه نحوها غير مرتبطتين بشخص غيرها، بل هي وحدها دون سواها، وإن أي أنثى أخرى لا يمكن أن تُصيّر جميلا لحال أخرى، وهذا ما يفرق به عن شعر امرئ القيس في المرأة -قاصدا النساء جميعا- ولن تفرق معه هذه أو تلك. يكوّن هذا التجديد في مفهوم المرأة في الشعر حركةَ الإبداع في المواضيع التي تطرق لها شعر الأقدمين. غير أن هذا الموضوع يبقى شائكا ومتداخلا، فمفهوم الاتباع والإبداع وتقييده بقيود عقائدية أضْفت عليه صبغة الجمود، والجمود هنا التمام والمثالية. قد يختلف القارئ مع بعض ما طرحه أدونيس، فهو يُعبّر عن رأيه ورؤيته، وتحليلاته هو، لكنه سيثير الكثير من التساؤلات التي يجب البحث والكتابة فيها، فالشعر العربي، ليس محض كلام موزون مقفى؛ بل حياة كاملة، كما وُصف ديوان العرب، وهو خاضع لقوانين، قد يكون الخروج عليها والثورة الإبداعية فاتحة عصر جديد من الحداثة الأدبية الشعرية العربية، من يدري.
**
الكتاب الثاني: تأصيل الأصول
يُكمل أدونيس ما بدأه في كتابه الأول حول الاتباع والإبداع عند العرب، فيبدأ بتأصيل أصول الاتباع، في الدين والسياسية منذ نهاية العهد الأموي حتى أوائل القرن الرابع الهجري، ويأخذ الشافعي، الفقيه العالم، مثالا في دراسة التأصيل والاتباع في الدين، إذ يعد الشافعي أول من “أصّل الأصول”، وعنه يقول أحمد بن حنبل “كان أفقه الناس في كتاب الله عزل وجل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم”. يدرس أدونيس آراء الشافعي الفقهية والشرعية في الدين، ومسالكه وقواعده في الاتباع والاجتهاد والقياس، وما ارتبط بهذه القضايا الفقهية والشرعية بالسياسة والمواقف الشرعية من ولاة الأمر والخروج عليهم.
يبحث، في الفصل الثاني، في تأصيل الأصول البيانية-الشعرية عند العرب، متخذًا الأصمعي والجاحظ مثالين عن الشعر واللغة، فيبحث في آراء الأصمعي وطرقه في تصنيف الشعراء، ما بين شاعرٍ وفحل، فيوضح منهج الأصمعي الصعب في تصنيفاته للشعراء فلا يكاد يرى الأصمعي شاعرًا ليصنفه فحل من فحول الشعر إلا إذا امتاز بأربع خصال هي:
1- الحظوة، المنزلة والمكانة. و2- السبق. و3- الأخذ من قوله. و4- اتباع مذهبه.
يعتمد الأصمعي في تصنيفاته على مبدأ الأوليّة الجاهلية، والأولية هي رمز الصحة، لأنها رمز الفطرة. أما الجاحظ، فيوضح آراءه الثابتة في أن قيمة الشعر العربي لغةً وفائدةً مقصورة على العربي، لأن الشعر لفظ، وبما إن المعنى موجود في كل اللغات، فتكون بلاغته وبيانه في اللفظ، وهذا ما يجعل قيمة الشعر العربي محصورا في العربية فقط، ويفقدها إذا تُرجم إلى لغة آخرى، فالمعاني واحدة في كل اللغات، لكن اللفظ هو ما يختلف، إذ يكون للفظ الكلمة وقعها في أذن المتلقي، وتفقد ذاك الوقع إذا تُرجمت إلى لغة آخرى، فيزول التأثير اللغوي الذي لن يفهمه سوى العربي من الشعر.
يؤصل أدونيس للإبداع والتحول في القسم الثاني من الفصل، ويبدأ بالحركات الثورية متخذًا منها منطلقًا لبدايات التحول والتغيير، ومن ثمَّ الإبداع في مواجهة الاتباع ومعاكسته. يأخذ من ثورة الزنج والقرامطة مثالين عن التحول بمحاولة تحسين ظروفهم السيئة التي كابدوا فيها، وضيقهم ذرعا بسوء ولاة الأمور، حتى دُفع الناس دفعا إلى الثورة على هؤلاء الولاة، والمطالبة بحرياتهم، وحقوقهم التي سُلبت.
يتطرق في القسم الثاني من الكتاب إلى الموقف الديني، المنهج التجريبي وإبطال النبوة، ويطرح أربع شخصيات لدراسة فكرها ومنهجها، وهي ابن المقفع، وابن الراوندي، ومحمد بن زكريا الرازي، وجابر بن حيان. يُعد ابن المقفع أول من أخذ موقفا من الدين منتقدا إياه والله والنبي، متخذا العقل مقياسا له، فهو ذو منهج عقلي لا يعتمد على القرآن أو السنة. أما ابن الراوندي وابن حيان فقد وصل معهما المنهج العقلي إلى ذروته، فابن الراوندي يعتمد على العقل في ردوده وحججه على الدين وما جاء به النبي، منكرًا قيمة الأنبياء ومكذبًا إياهم. واعتمد ابن حيان على المذهب التجريبي، فهو مؤسس النزعة التجريبية العلمية، ونحا في علم الكيمياء منحى عقليا اختباريا مستبعدا الخوارق، يختلف في هذا عن منهج أهل الكيمياء اليونانيين، الذين يستخدمون الخوارق في التفسير، فابن حيان عقلاني والحق عنده بالتجربة والدليل العقلاني. أما الرازي فقد انتقد النبوة، معتمدًا على العقل وحده في نقدها وتفنيدها، وإننا بالعقل وحده بإمكاننا معرفة الخير والشر والجيد والسيئ ولسنا بحاجة لنبي، فإذا كنا نميز بعقولنا سقطت الحاجة للرسل، فيكذبهم. ومما سبق نرى أن هؤلاء لم يعتمدوا على مذهب الاتباع، بل عمدوا إلى المذهب العقلاني في تفسير الدين وما ورثوه، وبذلك يمثلون مرحلة أولى من الثورة على الموروث، معتنقين الربوبية اللا دينية.
جاء الفصل الثالث عن الإبداع في شعرية الصوفية، وعلاقة الظاهر بالباطن، وبدايات الصوفية مع أبي يزيد البسطامي، ومنهجه وأقواله -البيّنة الكفر-، والتجرؤ على الذات الإلهية، ولا أرى فيها نوعًا من الإبداع، بل هو كفر محض، تجعل من الإنسان شريكا لله، وتُنزل من قدر الله، فيجعل هؤلاء المتصوفة من أنفسهم في مقام أعلى من الله أحيانا، تعالى عما يصفون. يقول البسطامي “سبحاني سبحاني” ويقول “ضربتُ خيمتي بإزاء العرش” ويقول “لأن تراني مرة خير من أن ترى ربك ألف مرة”، فهذا المنهج الذي اتبعه البسطامي، منهج كفري، وضال، ليس فيه أي إبداع ولا قيمة له إلا ببعض الشطحات الفلسفية.
خُصَّ الفصل الرابع في الإبداع والحداثة في الشعر عند أبي نواس وأبي تمام، والتجديد الذي سار عليه الشاعران في اللغة والمفردات والاهتمام بالمعنى وإشباعه بالمغزى والاستنباط كما في شعر أبي تمام، مخالفا بذلك المنهج القديم المتبع في قياس اللفظ على المعنى ومطابقته إياه، واستخدام الخيال والبعد عن الواقعية كما في شعر أبي نواس. يكمن التجديد في شعرهما في الخروج عن التعبير الطبيعي إلى التعبير الفني، كما في قول أبو نواس:
غير أني قائل ما أتاني * من ظنوني مكذبًا للعيان
أما القسم الثالث من الكتاب ففي جدلية الاتباع والإبداع. بحث الفصل الأول في معنى القديم والحديث، مفصلًا أكثر مما جاء به في تأصيل الإبداع، وفي مفاهيم السنة والقياس والإبداع (البدعة في الدين)، وفي هذا الفصل لم يأتِ بالشيء الجديد فهو شبه تكرار لما في التأصيل غير أنه توسّع أكثر.
والفصل الثاني منه في الحركة اللغوية، وتأثيرها في الشعر، والاختلاف بين مدرستي الكوفة والبصرة، فمدرسة الكوفة اعتمدت المذهب السماعي في اللغة والشعر، وأما البصرة فاعتمدت المذهب القياسي، مما أدى إلى خلاف بين هذين المدرستين. تأتى من هذا الاختلاف تأثيرهما في نقد الشعر، من ناحية تجديده والمحافظة على حداثته، وإنّ اختلاف لغة الشعر، بين لغة الحضر ولغة البادية، جعل الشعر القديم المعيار في لغة الشعر، فلغة الحضر، بعد أن اختلط العرب بالعجم وتمدّنوا، مالت إلى السهولة واللين، فرّقت لغة الشعر، مما أدى إلى رفض الكثير للغة الشعر الجديدة والمحدّثة.
والفصل الثالث في الحركة الشعرية. يأخذ أدونيس الصولي والآمدي مثالين عن النقد الشعري، وقد تكفّلا بنقد الشعر لغةً ومعنى ولفظا، فتناولا شعر أبي تمام والبحتري والخلاف الذي دار بين أنصار الاثنين بسؤال شعر مَن أجودُ مِن مَن؟ موضحًا منهج الاثنين في نقد الشعر. تبرز قيمة شعر أبي تمام في فلسفة شعره، فشعره يحمل من المعنى أكثر مما يبرزه اللفظ، فيدعو قارئه أو سامعه إلى الاستنباط والتفكير، وهذا ما خالف به الشعر القديم -الجاهلي- الذي يوازن ما بين اللفظة والمعنى، فتبقى اللفظة مقياسا للمعنى، ولا يحيل اللفظ إلى معنى آخر، لكن شعر أبي تمام، على عكس ذلك، فالمعنى عنده مُضمر، وما اللفظ إلا بوابة لفهم المعنى، وهو الخيال الشعري الذي أبدعه، والصور الشعرية، التي أساء الكثير فهمها، ومنهم الآمدي الذي ينقد بعضا من شعر أبي تمام، فيقول عن هذا البيت:
أجدِر بجمرة لوعة اطفاؤها * بالدمع أن تزداد طول وقود
“وهذا خلاف ما عليه العرب، وضد ما يعرف من معانيها، لأن المعلوم من شأن الدمع أن يطفئ الغليل، ويبرد حرارة الحزن، ويزيل شدة الوجد، ويعقب الراحة”. ففي رأيه الكثير من القصور، فهو لم يبلغ المعنى الذي أراده أبو تمام، فالمعنى واضح بيّـن، أن الدمع لا ينفع ولا يجدي، فكأنه وقود يزيد حريق جمر اللوعة، بدل أن يخمدها. بهذا المثال بإمكاننا أن نقيس على المعيار الذي كان متعارفا، في نقد الشعر، وما فيه من الخلل، فهو يجعل من الكلمة جامدة، ومحبوسة في قالب اللفظ، فينكر جمال الصورة الشعرية إن لم تأتِ كما هو متعاهد عليه.
ينهي أدونيس الكتاب الثاني بخلاصته، محاولا ربط الإبداع في الشعر وسعة اللفظ وإمكانياته في احتواء معانٍ متعددة تدعو للغوص من أجل فهمها وتخيّل الصورة الشعرية بجماليتها، بما يتبعه الصوفية في علاقة الظاهر مع الباطن -التجربة الباطنية-، وأن المعبّر عنه لا يساوي العبارة، ففي العلاقة الكثير من الرمزية، وهي ليست علاقة مطابقة، كما عهده العرب في شعرهم.
**
الكتاب الثالث: صدمة الحداثة وسلطة الموروث الديني
يستهل أدونيس كتابه الثالث من السلسلة بمدخل يشرح فيه الجو العام لهذا الكتاب، وموضوعه في الحداثة وسلطة موروث الماضي -سواء الفكري أو الثقافي أو الديني-. يُشدد هنا على أهمية تجديد الحاضر العربي شكلا ومضمونا ولا يعني هنا إلغاء موروث الماضي جملة وتفصيلا، بل في إعادة النظر فيه جملة وتفصيلا، والفرق بين الاثنين كبير وواسع. تتركز المشكلة في أن الحداثة التي بلغت العرب من الغرب يستخدمها العربي -كما يشير- إنجازاتٍ ونتائجَ جاهزة سواء على المستوى العلمي أو المناهج الفكرية أو المدارس النقدية الأدبية والثقافية، ولا يحاول الوصول إلى الأسس التي انطلقت منها، ويعني هذا إعادة النظر في طريقة التفكير والتعامل مع العالم المحيط بالمجتمع العربي ونظرته إليه من دون تأثير سلطة الماضي عليه.
أرى أن المقابلة ما بين النهضة الغربية والركود العربي، يفرق كثيرا، فالنهضة الغربية ليس عليها من سلطة غير سلطة الكنيسة، وليس عند الغرب موروث ديني-ثقافي كالذي لدى العربي، فعملية التحرر من سلطة الكنيسة الدينية-السياسية أسهل من نظيرتها العربية، فسلطة الموروث الديني لدى العربي من القوة بمكان أنها بقيت ثابتة لا تتزعزع رغم مرور عديد القرون. ولا يُمكن أن نوجّه اللوم إلى العربي أو أن نصفه بالتخلف والجمود، كون سلطة الماضي تدخل في منظور ديني، أدبي، ثقافي، اجتماعي، وعمليات التجديد الفكرية أو العقائدية كانت إنكارا للموروث الديني كما عند ابن الرواندي، أو الحركات الخارجية كالقرامطة، ونحن هنا في خضمّ صراع حقيقي بين الاتباع للماضي الثابت أو الاتباع لحاضر لم تكتمل صورته بعد وبقي في نطاق ضيق. لذا يجب أن يكون التجديد على مستوى ليس ثوريا بالكلية ولا تقليديا ينبع من الماضي بلا أي تأثير في الحاضر.
يورد في ختام مقدمته لهذا المدخل ملاحظة لا بد من الوقوف عندها في إعادة تقويم موروث الماضي “أخيرًا، أرى أن المقتضيات البدهية الأولى لإعادة التقويم هذه، أي لهذا النقد/ البحث، تجاوز مشكلة الثنائية، وبخاصة ثنائية التقنية، العرب/ الغرب. وليس هناك “غربي” متفوق نوعيا على “العربي”، بحيث يتحتم على الثاني أن “يفيد” دائما من الأول، ويظل تابعا له، إلى أن يأتي وقت قد تنقلب فيه المعادلة، ويصبح الأول تابعا للثاني. وإنما هناك إنسان واحد، حدث له في ظروف أو أوضاع معينة أن “يتقدم” أو حدث له أن “يتأخر”. فليس “التقدم” مسألة “غربية” كذلك ليس “التخلف” مسألة “شرقية”. إن هذه الثنائية أيضا من “ابتكار” الهيمنة الإمبريالية”.
جاء الفصل الأول من الكتاب بعنوان حدود العقل، وهو في أربعة أقسام. الأول: القاضي عبد الجبار: النظر، وفساد التقليد. والثاني: الغزالي: الفكر، وحدود العقل. والثالث: الفارابي: اللغة، والمحدَث. والرابع: ابن تيمية: الفكر، والبدعة.
يحاول أدونيس في هذه الأقسام الأربعة الوقوف على آراء أربعة من المفكرين في مواضيع مختلفة تصب في بحثه، ابتداءً من النظر، وهو التفكير في تحليل الموروث عقليا وعدم الآخذ بالموروث تقليدا دون فهم أو إدراك ونظر، عارضا بعض ردود أهل التقليد على كلام القاضي عبد الجبار ورده على ردودهم. والقسم الثاني عن الغزالي وتقسيمه للعلوم ما بين شرعي ودنيوي، نافع أو ضار، ودرجات وجوب العمل ما بين كفاية أو إلزام، وهو استعراض وتوضيح لآراء الغزالي في العلم التي تتلخص في عدة نقاط منها العقل محدود واستخدامه مشروط بالقرآن والسنة، والفكر هو استخدام العقل للوصول إلى المعرفة، ومجال الفكر وموضوعاته يكون في علاقة مع الخلق أو الخالق، والعلم الذي يطلب لذاته أو منفعة دنيوية ولا يتعارض مع الشرع فهو فرض كفاية -يسقط عن الجميع إذا قام به من يعوضونهم ويسدون الحاجة-، والعلم هو علمٌ بالقديم أو تفسير للقديم أو لا يتعارض معه بل يكمله، والفكر هو الأصل والعلوم والأحوال والأفعال هي ثمرته، وأخيرا العقل يهدي إلى صدق النبي وفهم سنته. هذه النقاط التي يذكرها أدونيس في عرض موجز لآراء الغزالي، ولا يمكن الأخذ بصحتها المطلقة دون الرجوع إلى مؤلفات الغزالي. والقسم الثالث عن الفارابي، وفيه أيضا عرض لآراء الفارابي في اللغة والمحدَث والخلاف بين الملة والفلسفة، ويحاول الفارابي -من خلال ما يستعرضه أدونيس من أقواله- فهم آلية الاختلاف وأسبابه. وهذا العرض لا يكفي القارئ أيضا في استخلاص رؤية واضحة عن منهجية الفارابي وسلامة مقاله، بل يكتنفها من الغموض ما يحتاج إلى شرح وتفصيل، التي ربما تجاوز عنها أدونيس لأنها قد تُحيله إلى فضاءات أخرى بعيدة عن مادة بحثه، وحاول في هذا الفصل استعراض محاولات التجديد من المفكرين الذين بيّن آراءهم ومواقفهم من الفلسفة والفكر وعلاقة ذلك بالاتباع. أما القسم الأخير فيخص ابن تيمية ودوره وآراءه في الرد على المبتدعين والبدع، ومنهاجه في تفصيل البدعة وأنواعها، والأمر متعلق بالجانب العقائدي وما يخص حديث النبي وما أمر به وعمل به أصحابه من بعده. يتناول دور ابن تيمية في هذا الأمر كون الابتداع أحيانا قائم على الاتيان بالجديد الذي لم يفعله النبي، وهو ما يمثل الفكر وآلية القيام بفعل جديد ونسبه للدين، وما يقوم به ابن تيمية هو الرد على البدعة وتفنيدها ومحاربتها بكتاب الله وسنة نبيه، وهو ما يمثل الاتباع الوجه المقابل للإبداع -من البدعة-. كثيرا ما قدّم أدونيس الإبداع الفكري، فيما يخص الدين، كونه أول محاولات التجديد في الفكر العربي قديما، وهذا ما يجعل موضوع الإبداع هنا يخص العقيدة أكثر مما يخص الأدب وتحرره من قيود الماضي، ويفتح على الإبداع الأدبي بابا، يجب غلقه، هو تحريره من السلطة الدينية المتوارثة. يُخرجنا ربط الإبداع الأدبي بالابتداع في الدين من حدود إلى الأدب ويدخلنا في حدود الدين، وتضيع في هذه الحدود الكثيرُ من الأهداف التجديدية التي لا تمس الدين، لأنه عقيدة العربي المسلم التي لا تقبل النقاش أو الجدال. ويُعلل هذا الأمر كون الدين هو المحرك الرئيس والحقيقة المطلقة عند العربي المسلم، ولا يمكن تجاوزه أو التغافل عنه، دون فهمه على نحوٍ كاملٍ وشاملٍ من أجل التغيير وفهم الواقع وتطويره.
يتناول الفصل الثاني من الكتاب، وهو كسابقه هيكليا، أربعا من الشخصيات الإسلامية هم محمد بن عبد الوهاب، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا، وعبد الرحمن الكواكبي. ويستعرض أفكار هؤلاء وآراءهم. يبدأ بمحمد بن عبد الوهاب، والذي عدّه تقليدا للموروث، إذ اتّبع ما كان عليه الأوائل من الشرح والتفسير والنقل، ومحاربة البدعة التي انتشرت، طارقا سبيل الأولين من أهل العلم المسلمين. أما محمد عبده فيمثّل فكرا إسلاميا تنويريا جديدا، فيعمد إلى وجوب النظر العقلي في الدين وليس التقليد الأعمى والنقل الذي لا يُفهم كُنهه، وهو بهذا يجسّد مرحلة إعادة النظر في الحديث والتفسير بما يتناسب والحاضر ومشكلاته، من أجل التطور في عصر يتقدم كل شيء فيه بسرعة، ولا عزاء للجالسين. فكيف يأتي هذا التطور وهذه النهضة؟ إن جواب محمد عبده هو بالعلم والتربية الأخلاقية. فاستيراد تقدم الغرب ظاهريا فقط، يعني تغييرا شكليا، وإن التغيير الذي يعمل على إصلاح الواقع وتطوره وتقدمه هو تغيير النفوس وإصلاحها. يتم هذا بالعلم، والفكر، وهما معارضان للتقليد الجامد. في هذا يقول محمد عبده، كما ينقل أدونيس، حتى مسائل الاجتهاد كانت في قضايا فرعية تناسب مشكلات زمانها، لذلك علينا البحث والاجتهاد ما يناسب مشكلات عصرنا، ولا يعني أن ننقل عصرنا ومشكلاته إلى أبعاد الماضي وقوانينه وحالاته التي تختلف كل الاختلاف عن واقعنا الحالي. أما فيما يخص السلطة الدينية فمحمد عبده يؤكد أنه لا سلطة دينية مطلقة، وولي الأمر هو من تختاره الأمة لتسيير أمورها وإدارتها، وسلطته ليست سلطة مطلقة ولا سلطة إلهيّة، وللأمة حق خلعه إن رأت ذلك من مصلحتها، فإن لم يؤدِ واجبه انتفت ضرورة وجوده. لكن في ذات الوقت لا يُبعد الدين/ الشرع عن إدارة الحكم، فالشرع هو المنظم لمعاملات الناس والحاكم بينهم. تبرز لنا هنا نظرة محمد عبده الواعية في تحكيم العقل والفكر في الموروث، ولا يعني تحكيم العقل إنكارَ الموروث، بل يعني تجديد النظر في الموروث بما يتناسب وزماننا، من دون أن نعامل الموروث على أنه يخصّ حقبة معينة بحالاتها ومشكلاتها وزمانها ومكانها وناسها، فنحن نعيش في حقبة أخرى مختلفة كل الاختلاف عن حقبة هذا الموروث. يُولَّد لنا العمل بالتقليد المطلق الأعمى مشكلةَ سوء معاملة الموروث لمشكلات الواقع، مع ضرورة مواكبة التطور في هذا العالم، فيؤدي كل هذا إلى تراجع الأمة الإسلامية وركودها. أما الشخصية الثالثة فهو محمد رشيد رضا، وجسّد التفكير تفقُّهًا. تتمحور فكرته الإصلاحية والنهضوية في الرجوع إلى الإسلام، ولا يعني هنا تقليدا فقط، بل منهاجا أخلاقيا وتربويا من أجل إصلاح حال الأمة، لا سيما في حقبة التشتت والضعف وما يواجهها من خطر الاحتلال الأوروبي وضعف العثمانيين، بل وانحراف حكومة الاتحاديين في تناولها قضايا الأمة الإسلامية إذ أصبحت ذيلا للأوروبيين بعد عام 1910. يقف محمد رشيد رضا بجنب أمير مكة الحسين في ثورته على العثمانيين، لما يراه أن في حال سقوط دولة العثمانيين فأفضل بيئة لقيام دولة إسلامية هي أرض الحجاز، ولكونها مناوئة لإلحاد الاتحاديين. هذه النهضة التي يدعو لها محمد رشيد رضا هي نهضة إصلاحية تكون بالتمسك بالدين الإسلامي وقيمه، من أجل تجديد الحياة، وبناء مجتمع متماسك وقوي، في مستوياته ومجالاته جميعا. يبدأ الإصلاح، إذًا، بالرجوع إلى الإسلام واستعماله منهاجا لإصلاح واقعٍ بَعُد أهله عن الإسلام، حتى يتسنى لهم، بعد الإصلاح الديني والأخلاقي والمعرفي، التطلعُ لخطوة تالية هي إصلاح الواقع العام والنهوض به من أجل التطور. أما الشخصية الرابعة فهو المفكر عبد الرحمن الكواكبي وجسّد الفكر اصطلاحا. الكواكبي من أهم مفكري النهضة العربية إن لم يكن أهمهم، وينطلق الكواكبي من سؤالين هما ما سبب الانحطاط؟ وما أفضل وسائل النهضة؟ فأما سبب الانحطاط فيرجع الكواكبي سببه إلى الاستبداد السياسي، وما يجره من ويلات ومصائب على الأمة، في سوء الإدارة واستغلال الدين وفساد الحاكم، وانتشار الظلم وكل ما يمكن أن يكون انحطاطا وإبعادا للمعنى الحق للدين السليم. وهذا ما يختلف به المجتمع العربي عن نظيره الغربي، حيث يكون الحاكم في خدمة الشعب يسير على قوانين شعبه ويفعل ما هو مطلوب منه. أما الحاكم المستبد فيرى الشعب في خدمته ويسير على قوانينه هو ويفعل ما يطلب منه فقط. إذًا، المشكلة في حكم فاسد استغل كل الأسباب ليستبد بالحكم فيترتب على ذلك نتائج كارثية في واقع الأمة. أما وسائل النهضة عنده ففي منهاج إصلاحي شامل، يبدأ من دراسة الحاضر ومشكلاته وتشخيص علّته، وإن سبب الخلل النازل هو الجهل الشامل، ويجب توجيه اللوم للأمراء والعلماء لعدم اتفاقهم من أجل النهضة. يأتي بعدها إصلاحُ الفرد وإحياء حياة الجدة والنشاط والعمل وأن يكون ابنا للمستقبل والجدة، لا ابنا للماضي والقِدم. هذا ما يختلف به الغربي عن العربي، حيث الغربي يبحث عن الجدّة وهو في عمل دائما من أجل التقدم، والعربي في حالة جمود وتقاعس وعيش في الماضي دون العمل على إصلاح واقعه وتغييره. فكر الكواكبي نابع من أصل إسلامي خالص، ومنفتح في ذات الوقت على الغرب وإنجازاته، من أجل الاستفادة من نافعها وتجنب ضارها، وهو صاحب فكر راقٍ ومنهج قيّم، فلا هو منغلق على ذاته متشبث بماضيه، ولا هو منفتح لدرجة أن ينسى نفسه وهويته وقيّمه ومبادئه، بل يقف على الوسطية، علم ودين، أخلاق وفكر. ولا ينبغي أن تكون علاقتك مع الآخر احتقارية أو انتقاصية سواء بالنظر إلى نفسك أو بالنظر إليه، بل علاقة توافقية نفعيّة إصلاحية من أجل استثمار معرفته بأفضل ما يمكن، وكذلك لا أن تنسلخ عن ذاتك وتندمج في الآخر اندماجا فجّا لا يمت لواقعك ومجتمعك بصلة ولا رابط. يشخص الكواكبي أمراض الأمة أنها التزام بالعلوم الدينية وبعض الرياضيات وإهمال العلوم الأخرى التي لا يتقدم الواقع إلا بها، وكذلك يحضّ على الوفاق والتوافق وترك التمذهب والاختلافات.
القسم الأول من الفصل الثالث حوار لإحدى ندوات “الديمقراطيين العلمانيين” وحديث عن تحديث العقل العربي وما يواجهه التحديث من مشكلات، وقيود الدين وآليات استخدام اللغة، والعلاقة مع الغرب، والنظرة النقدية إلى الذات. (أقترح قراءة الحوار كاملا، كونه اشتمل على كثير من المواضيع التي لا يمكن إيجازها بعدة أسطر). أما القسم الثاني فمؤلّف من نصوص كتبها أدونيس عن الثورة الإيرانية التي تزعّمها الخميني سنة 1979، وطرح فيها رؤاه وآراءه، مؤيدا إياها. يبدو في هذه النصوص أنه متأثر بالثورة ويحمّلها أكثر مما تحتمل أو مصدقا لما طرحه الخميني وقاله، غير أنه يقول إنه لا يتبناها ولا يدري إن كانت الوقائع ستثبت صحة تطلعاته أم تكون امتدادا لسلطة قمعية تحت مظلة دينية. لكن أهم ما تجسّده الثورة الإيرانية لأدونيس هو التغير الذي طرأ وجعل من الإسلام مادة للحركية والتغيير وليس مجرد نصوص يُتقيّد بها على نحوٍ نظري بعيد كل البعد عن العمليّة، وطامح إلى أن يثور العربي ثورته. لكن مع تقدم الأيام ومرور السنين وبعد أكثر من ثلاثين عاما، نرى موقف أدونيس الرافض للثورة السورية، وبذات الوقت تحول النظام الإيراني إلى نظام قمعي يعتمر الدين ويتكلم في منظوره، غير ما كان ينتظره أدونيس وقت كتابته هذا الفصل. والقسم الثالث من الفصل مؤلّف من تعليقات عن كل ما ذُكر في الكتاب، ويمكن ربطه بخاتمة الكتاب.
يسعنا إيجاز فكر أدونيس من أجل النهضة:
1- بما أن العربي/ المسلم مرتبط ارتباطا وثيقا بالنص القرآني/ (الديني الأول) فلا يمكن إهماله بأي حال من الأحوال، والانطلاق بعد ذلك من خلال فهم النص بقراءة جديدة لأجل أن يكون متناسبا ومتطلبات العصر الجديد.
2- يجب تفكيك الماضي -الموروث والثقافة والتاريخ وكل ما يرتبط بالماضي- ونقده وتقويمه وفهمه، ثم الانتقال إلى الحاضر من أجل النهضة والتقدم، فلا يمكن تقويم الحاضر إلا بتقويم الماضي الذي يمتد منه.
3- يجب تحرير النصوص الأولى (دينية أو ثقافية) من القراءات الأولى (النصوص الثانية)، كون النصوص ثابتة والقراءات متغيرة، لذلك يجب أخذ الثابت وإعادة قراءته بما يتوافق مع العصر الجديد، ولا يجب أن تبقى القراءات المتغيرة، أو ما يسميها “النصوص الثانية”، قيدا للفكر العربي وتجعل أي قراءات جديدة رازحة في قيودها، ثمَّ تصبح هذه القراءات الجديدة بثوب الماضي، وما هي إلا امتداد للقراءة الأولى، فاقدة كل صفات الجدة وعاجزة عن القيام بذاتها دون تأثر بالماضي.
4- إن الغاية هي الإنسان، ويجب أن تكون الأفكار والمذاهب في خدمة الإنسان لا العكس، وبعدّها نصوصا وقراءات فتكون قبوليتها بما تقدمه للمرء لا بما تفرضه عليه. فالإنسان هو الثابت والقراءة هي المتغيرة، فالمتغير هو من يقع عليه التغيير والتجديد لا الإنسان.
5- أن تكون غاية البحث طرحَ الأسئلة والإجابةَ عنها من أجل طرح أسئلة جديدة، أي عملية بحث مستمر وتفكير دائم لا يتوقف عند حد معين أو جواب معين. يقول إن مشكلة العربي هو البحث عن جواب لكي يتوقف بعده لا أن يستمر في طرح الأسئلة. إن طرح السؤال هو توليد لسؤال آخر لا يصل إليه إلا بالإجابة عن سابقه، لتبقى عجلة الفكر في حركة مستمرة لا يصيبها العطل أو الخلل، فأي توقف يعني توقف الحياة ويكون التخلف واقعا لا يمكن التهرّب من الاعتراف به.
**
الكتاب الرابع: صدمة الحداثة
(يُشير أدونيس في بدايته إلى أنه لم يتناول إلا الظواهر الشعرية التي يرى أنها تفيده في مسألة الحداثة الشعرية).
يبدأ الكتاب بتسليط الضوء على مفهوم الحداثة وجذور الحداثة الشعرية التي تمثلت ببشار بن برد الذي قيل فيه “أُستاذ المحدّثين… من بحره اغترفوا، وأثره اقتفوا”. ومن جاؤوا بعده أبو نواس وأبو تمام. لم يُضف في فصوله هذه الشيء الجديد الذي أبحر فيه في كتابيه السابقين سوى التركيز على مفهوم الإبداع الأدبي أكثر، ثم الانتقال من الخطاب إلى الكتابة. كان العربي سابقا يعتمد على السمع، وقد ينسى كلمة في قصيدة ما فيبدلها كلمة أخرى على ذات الوزن، فيبقى الوزن لكن يضيع جهد شاعر سهر الليل لإيجاد الكلمة التي تناسب بيته، ومن ثم اهتمام العرب التدريجي بالكتابة، حتى أصبحت لا غنى عنه فيقول معن بن زائدة “إذا لم تكتب اليد فهي رِجلٌ”.
يسلط الضوء بعد ذلك على منعطف مهم في الأدب العربي نتج عن لقاء الشرق والغرب في القرن التاسع عشر، وما كان لاطلاع العرب على الأدب الغربي -الفرنسي والإنجليزي- من تأثيرات آتت أُكلها في تغيير نظرة بعض الأدباء في الشعر، وبداية عصر النهضة الشعرية، فيأخذ نموذجين عنهما، هما الشاعران البارودي والرصافي. أعاد البارودي بشعره ومواضيعه وأسلوبه الشعري النور إلى الشعر العربي بعد أن بهت في الحقبة المظلمة التي شهدها العالم العربي على المستوى الأدبي بعد احتلال المغول بغداد سنة 1258م حتى بداية القرن التاسع عشر، فالبارودي حلقة وصلٍ جديدة بين الشعر الجاهلي القديم وشعره العربي. يؤكد أدونيس مشكلة استمرَّ توّلدها في كل عصر وهي جمود المقاييس التي تعدُّ هذا الشعر شعرا جيدًا، إن طابق ما كتبه العرب الأوئل في الشعر، أي إن شعرهم شعرٌ كامل، ومهمة الشاعر العودة إلى الوراء لأجل البحث عن الكمال، وهذا ما بيّـنه في الجزئين السابقين. إن جعل الشعرَ الجاهلي المعيارَ، وأنّ كل شعرٍ لا بد أن يكون مترابطًا شكلا وهيكلة وألفاظًا بالشعر الجاهلي، يقتل الإبداع الشعري، ويخرج من مفهوم الشعر، فالشعر من الشعور، ويسلبُ الإنسانَ حرية التعبير بما يفرضه من قيود وزنية وموضوعية. فإما أن تُعبر كما عبّر السابقون؛ وإلا فإنك ستبقى بمرتبة أدنى منهم بكثير، وربما لن يصنف شعرك شعرا، حتى أصبح التجديد والنهضة الشعرية في كتابة شعر مشابه للماضي، فأين التجديد والحداثة في الشعر؟ يبقي التشبث بالماضي، وسجن الشعر فيه، الشعرَ في معزل تماما عن أي تجديد، أو نهوض يجاري تطور الحياة والزمن. فكما أن على المرء أن يُخاطب المقابل بلغة يفهمها فعليه أن يكتب الشعر بلغة وأسلوب يلائمان وجدانه وما يختلج في نفسه أولا، ويلائم العصر الذي يعيش فيه، لا يعني هذا أن ننكر الشعر الجاهلي أو نُقصيه، بل أن يكون للشعر مراحل متعددة، ومختلفة، يُحكم على كل مرحلة بقوانين تناسبها فنيًّا ولغويًّا وأسلوبيًّا مستمدة من حياة الشاعر والبيئة المحيطة. بهذا يكون الشعر كونًا واسعًا يضم عوالم شعرية مختلفة، وتبقى أفضليّته أمرًا يرتبط بذائقة المرء ومعاييره بعد امتلاكه خصائص الشعر والشعريّة.
أما الرصافي، الشاعر العراقي المعروف، فيتمثل شعره بمواضيعه الجديدة والتحررية والدعوة لاستخدام العقل ووقوفه على مطامع الغرب في الشرق، ويدرس بعضا من فكره وشعره. ينقد الرصافي الغرب وسياساته، فمن ناحية المدنية والحرية فالغرب يؤديها فكرةً لكنه يعارضها سياسةً “… فهو يلاحظ لدى الغرب انفصالا بين النظرية والتطبيق. فالغرب مثلا، ينادي بالحرية، نظريا، لكن السياسة الغربية تجيز استعباد الشعوب. هو يمنع الاسترقاق كلاميا لكن يمارسه عمليا. وعلى هذا فإن الحق لا أهمية له ولا معنى خارج الغرب”. “ويدعي الغرب مثلا الفصل بين الدين والدولة، وأنه لذلك ضد التعصب الديني والطائفي، والواقع أن هذا الادعاء تكذبه الممارسة. ويمثل الشاعر على ذلك بخطاب الجنرال غورو في بيروت حين أشار إلى الحروب الصليبية،… فهناك في الغرب فصل ظاهري بين الدين والسياسة، والحقيقة أن بينهما وَحْدة، وأن الجنرال والكردينال واحد،…”. “أما العلاقة الشرق بالغرب فهي علاقة المُستغَل والمُستغِل”.
ومن الحركات الشعرية والنقدية الجديدة جماعةُ الديوان التي تزعّمها العقاد وشكري والمازني، ودعت إلى رفض النموذجية وتحقيق شعرٍ يتآلف مع المكان والزمان، أي أن يعبر عن الحاضر بعين الحاضر، لا بعين الماضي. إن التجديد الشعري الذي جاءت به جماعة الديوان، وإدخال الذاتية والرومنطيقية، ووحدة القصيدة، والتغيير في البنية التقليدية للقصيدة، جاء بعد الاطلاع على الشعر الفرنسي والإنجليزي، والتأثر بهما. لا يُمكن أن يُوصف هذا التجديد بالإبداعية تماما لأنه متأثر بغيره، والأفضل أن يقال عنه التجديد التأثري أو التأثريّة بدل الإبداع، ولولا الاطلاع على ما نسجه شعراء الثقافات الأخرى لم يكن ليأتوا بما أتوا به. وإلقاء اللوم على الحقبة الماضية، لأنها كانت مظلمة من الناحية الأدبية والشعرية، فلا يُمكن الأخذ به أو أن يعزى إليها سبب تعطّل الإبداع عند الشعراء العرب، ولزمهم أن يأتوا بنظم جديدة ينضمون بها شعرًا يعبّر عن مرحلة جديدة ومختلفة عن الموروث الشعري الثابت القواعد، الذي كتب به العرب على مدار قرون.
والحركة الثانية فهي مدرسة أبولو، ومن شعرائها أبو شادي الذي تأثر بخليل مطران -كتب عنه أدونيس فصلا تناول فيه شعره نقدًا وتحليلا-. إن ما جاءت به مدرسة أبولو وعمدت إلى تشجيعه، في بناء نظام شعري جديد، يتحرر من القافية والوزن ويشمل الوحدة العضوية والموضوع في القصيدة، ويكون ذا علاقة ذاتية بالشاعر والطبيعة. يمثّل الشكل الشعري القديم مرحلة في إعادة تعريف الشعر، ومن ضمنها الكتابة في أنواع شعرية جديدة كالشعر الحر والمرسل والشعر النثري. كان كلُّ هذه الخطوات التي قدمها شعراء مدرسة أبولو مرحلةَ وعي جديدة بمفهوم الشعر ودلالاته، واستقلاله عن القديم، حتى لا يبقى الشعر حكرًا على شعراء معيّنين، وعصر معين، شرّعوا طريقا واحدا. إذًا، لا بد من نظرة جديدة ورؤية لمستقبل الشعر تخلصه من كل القيود التي تجعله في جمود الكمال الذي لُفَّ به، مستفيدين مما وصلت إليه الأمم والثقافات الأخرى في كتابة الشعر.
اصطدمت هذه الحركات الشعرية الجديدة والداعية للتجديد بحاجز، هو خط الصد في وجه أي تجديد أو خروج عن النظام الشعري المتعارف عليه، المشكلة التي واجهها الإبداع وواجهتها النهضة الشعرية الجديدة- بمفهوم الأصالة، وأن أي نُظم شعرية جديدة تُعد خروجا عن المتعارف عليه، لذا فهي غير صالحة بل ليست عربية، وهنا يكتب أدونيس عن مفهوم الأصالة الذي يجب أن يعامل الشعر على أساسه: “الشعر العربي الذي يمكن أن أسميه أصيلا، في ضوء هذا المنظور، هو الشعر العربي الذي يبحث عن نظام آخر غير النظام الشعري القديم، أي هو الذي يصدر عن إرادة تغيير النظام القديم للحياة العربية، وعن طموح الفئات الجديرة بهذا التغيير، والقادرة على تحقيقه، والعاملة له، لأنه قضيتها الأولى ومصلحتها الأولى. ولأنها، بذلك، تمارس دورها التاريخي والطبيعي. إنه الشعر الذي يغير أولا طريقة استخدام أدواته، لكي يستطيع أن يغير طريقة التذوق، وطريقة الفهم، ولكي يتغير، تبعا لذلك، دور الشعر ومعناه عما كانا عليه في النظام القديم للحياة العربية”.
من المشكلات أيضا التي يواجهها شعر التجديد والنهضة كان النظرة المدرسية الجامدة للشعر الجديد، ويسمي أدونيس هذه الظاهرة بالإحالة، وهي ذات ازدواجية، الأولى: إنها تقوم بالتعويضية، أي تأتي بشعر مترجم، دائما ما يكون أقل مستوى من الشعر الجديد وتكيل له المدح والانبهار وتُحيل نظر القارئ المثقف إليه، والثانية النقدية: تنقد الشعر العربي الجديد بالبحث عن عناصر، هي في الأصل غير شعرية، بمعنى أو بآخر تُحاكم القصيدة، وتبرز سلبياتها، لكيلا يكون له صدى، وتبقى أسيرة النظام الشعري القديم.
يخصص أدونيس فصلا لدراسة أدب جبران خليل جبران، وما له من قيمة أدبية وفنية ولغوية، والمواضيع التي كتب فيها وعنها، وتركز أدبه في الخروج على الماضي، ونظرة جديدة لعلاقة الإنسان مع الحياة والدين والتقاليد، وذلك من خلال أدبه الذي توزع على القصة القصيرة، والحكاية، والمقالة، وقصيدة النثر والوزن.
إن مشكلة النمطية والارتداد من العوائق التي يواجهها عصر النهضة، فنمو المجتمع العربي ناقصٌ، إذ هو ينمو ظاهريا على السطح لكنه لا يتجذر إلى الأعماق، وبذلك يبقى حبيسا فيما يُصدّر إليه. ولسلطة السياسة على الثقافة أثرا سلبيا في مسار المجتمع، فالعلاقة بينهما ليست علاقة متداخلة وتكاملية بل علاقة تابع ومتبوع. يقول في وصف هذه العلاقة: “هذه الصلة الجوهرية بين السياسة والثقافة هي ما يجب أن نلح عليه في المجتمع العربي. ذلك أن انعدام هذه الصلة لا يقصيه عن المشاركة الحية في بناء الحضارة وحسب، وإنما يقوده كذلك إلى مزيد من التآكل والتفتت في الداخل، عدا أنه يبقيه تابعا خاضعا في مدار الخارج”. وفي موضوع شكل الإيصال، وجمود الأسلوب وتقيّده بالماضي، مدار اشتغال أدونيس، يرى أن الشاعر يجب أن يتحرر بشعره من الثوب الذي ورثه من القُدماء، وأن يُفصّل ثوبًا جديدًا، يكون مناسبًا لشعره من ناحية الشكل والمضمون والأسلوب والطريقة التي يُعبر عنها والتفاعل ما بين الفكرة واللفظة، وتكون علاقته بالشعر الموروث علاقة إرث يدفعه إلى التغيير والتجديد، لا أن يكون عبدًا ومستغَلًا من قبل هذا الإرث الشعري. إن غاية الشعر إبداع روحٍ وجسدٍ جديدين، مرتبطان بواقعٍ معين ومحدد، فمن غير المعقول أن تُعبّر عن حدث جديد بأسلوب قديم، فأنت مُقلّد غير مُبدِعٍ، وهذا ما يصطدم ونبع الشعر الدائم التدفق من النفس الإنسانية العميقة. تقابل ذلك مشكلة أخرى في عصر النهضة هي ثقافة المتلقي، فعلى المتلقي أن يقرأ الشعر ويفهمه ويتفاعل معه، ليس بمنظار السابقين، بل بمنظار إبداعي يوازي عمق الشاعر، حتى يبقيان في مستوى واحد لينهض كلاهما بالشعر، فرجل واحد لا يُمكن أن يتقدم بالشعر وحده. يعلل أدونيس جمود ثقافة المجتمع كله في ارتباط الشعر بالموروث الديني العقائدي الأيديولوجي الكامل، غير القابل للتغيير، وما ذلك إلا نتيجة تراكم ثقافة الاتباع على مدى قرون. ويشير إلى أن التحرر الشعري يبدأ من فصل الشعر عن الدين، وإلا سيكون الحل في الثورة على الإرث الديني، ثم يخرج الشعر من ثوب القديم الموروث. غير أن هذا أيضا سيكون تغييرا ناقصا وثورة غير مكتملة، فالخروج عن الشعر سيكون نكاية بالموروث الديني لا إيمانا بتجديد الشعر ونهضته بما يلائم العصر. ويقول سيبقى مستقبل الشعر يكتنفه الشك.
يتناول أدونيس بعد ذلك صدمة الحداثة، والبدء بالثورة على القديم، فكريا وفلسفيا وشعريا. لكن ما يقع فيه أنه يربط الحداثة بالثورة على الدين، فهو يعيب ربط الشعر بالدين، وعدّ الموروث الشعري مقدسا، لأنه ارتبط بالدين في ثنائية متلازمة استغلت من السياسة، وفي ذات الوقت يستشهد بثورة العقل والفلسفة لدى ابن الراوندي والرازي وابن حيان، فيكون منطلق الثورة عنده بالخروج على الله، ومحاربة الدين تحت مسميات الحداثة والتفكير وبناء مدينة الإنسان وإزالة الخط الفاصل بين الله والإنسان، كما يفعل بعض أتباع المذهب الصوفي. فالحداثة عنده في التجاوز والخروج، وهذه كلمات تُوحي بالتمرد، فتُنشئ سَلَفا قاعدةَ صدٍ في وجهها. وأرى أن ربط التطور الفكري واستخدام العقل لا يعني أن نشكك في الدين وفي الموروث العقائدي، وإنْ وضع تحت مجهر الدراسة والفحص والتنظير، ويجب أن يبقى منفصلا عن موضوع الإبداع الفكري والأدبي. هنا لا بد أن نفهم ما الدين وما الفكر، وهل يعني الخروج على الله، وما إني أفكر، وأرفض التقليد الذي ارتبط كل شيء به؟ لا مناص من أن يكون التوجه في دراسة فكر أصحاب التقليد وليس في ماهية العقيدة والدين. فالله الذي أبدع الكون ووصف نفسه ببديع السموات والأرض، لن يمنع عبده من الإبداع، فالإبداع لا يتعارض والدين.
إن الخطوة الأولى التي يؤكدها أدونيس، من أجل بداية عصر النهضة، هي في إعادة النظر في الموروث الثقافي والفكري والفلسفي، وتناول أي ظاهرة فلسفية على أنها إرث فكري، بعيدًا عن محكمة الدين. ولا يمكن الثورة على هذا الشكل الثقافي المتوارث على مدى قرون إلا بالثورة على المسببات. المسألة معقدة وشائكة ولا يمكن تغييرها بسرعة فائقة، فهي تصادم موروثا فكريا ودينيا واجتماعيا وأدبيا وثقافيا، وتقع مسؤولية ذلك على عواتق أمة بأجمعها لا أفراد منها، أي وعي عام وتضافر جهود جيل بعد آخر، حتى يصل العربي إلى مرحلة الإبداع دون الحاجة لتسفيه وانتقاص كل موروث محلي، أو الامتثال واتباع أي موروث خارجي. والخطوة المهمة الأخرى في إعادة النظر في الشعر وتعريفه. يصفُ أدونيس سرّ الشعر والمزيّة الشعرية بأنهما “في التعبير عن عالم تقف أمامه اللغة العادية عاجزة، فهذه اللغة محدودة في حين أن هذا العالم غير محدود”. ويقول “تعلمنا هذه الكتابة إن علم جمال الشعر، وباختصار إن علم الجمال، ليس علم جمال الثابت، بل علم جمال المتغير”.