شعر ابن الفارض وحبُّ الخضوع
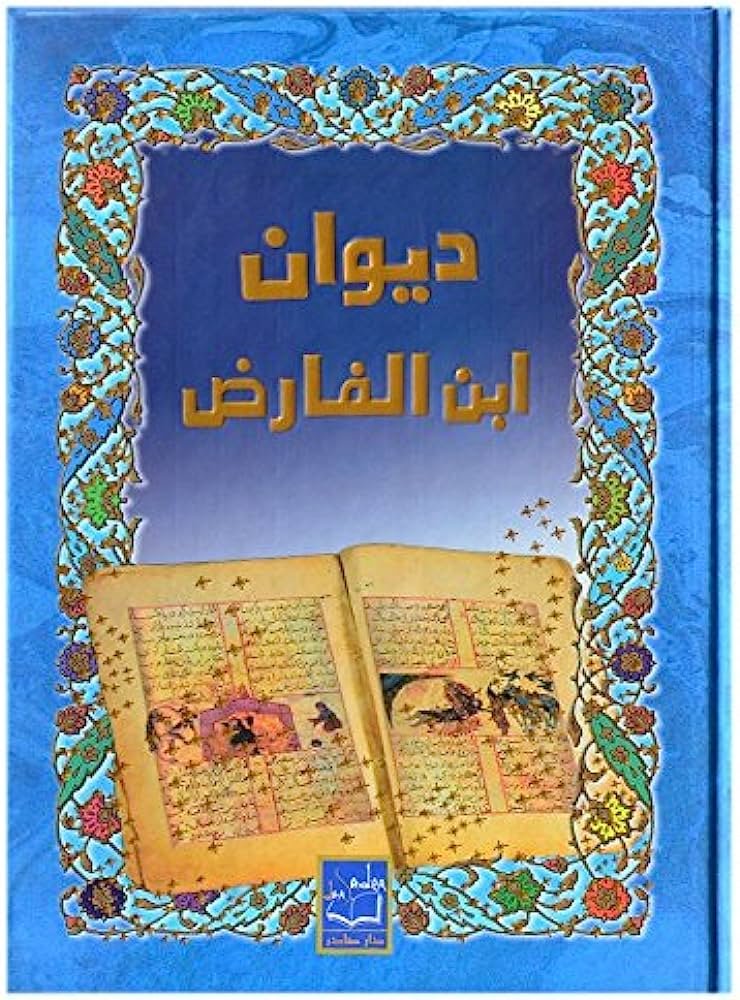
وُلد الشاعر المتصوف عمر بن الحسين بن الفارض الحموي الأصل في القاهرة سنة 576 هـ (1181م). لُقِّبَ أبوه بالفارض لأنه كان يفرض الفروضَ للنساء على الرجال بين يدي الحكَّام، وذاع صيت عمر باسم ابن الفارض. كان ابن الفارض يتمتَّعُ بوسامةٍ وسناء وحسن طلَّة وبهاء، تُروى في أسباب تصوفه حكاية جاء فيها أنَّه دخلَ يوما المدرسة السيوفية في القاهرة فرأى شيخًا لا يُحسن الوضوء فعاب على الشيخ فعلَه، فطلبَ منه الشيخ مخاطبًا إياه باسمه أن اتركْ مصرَ واقصد الحجازَ فلن يفتح الله عليك في مصر. تعجَّب ابن الفارض من معرفة الشيخ باسمه وهو يتلقيه أولَ مرة، فأشار الرجل بيديه فأبصرَ ابن الفارض مكةَ أمامه، فقصدها ودخلها في حينها. انقطع ابن الفارض في شعاب مكة خمس عشرة سنة سائحًا في وديانها وجبالها، ثم سمع يومًا صوت الشيخ يناديه ويطلب منه العودة إلى مصر ليحضرَ وفاته ويصلِّي عليه. لا تبدو القصَّة المذكورة قابلة للتصديق أو حتى تصح وما في حركة الشيخ بيده وترك ابن الفارض يبصر مكة من القاهرة إلا كما وردَ عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج، فقال جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ، قُمْتُ فِي الحِجْرِ، فَجَلَّى اللهُ لِي بَيْتَ المَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ -وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ-. ولا أحسبُ عاقلًا فضلا عن مسلم يُسلِّم بهذه الخرافة المنسوبة إلى ابن الفارض، وإنْ صحَّت جدلًا فما هي إلا من تبليس إبليس.
انشغلَ ابن الفارض بالشعر نحو أربعين سنة، ولُقِّب بسلطان العاشقين، وله قصائد كثيرة ومشهورة لا سيما التائية الكبرى المسماة لوائح الجَنان وروائح الجِنان، ثم عدل ابن الفارض إلى اسم جديد بعد أن ادَّعى أنَّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وطلب منه أن يغير اسمها إلى نظم السلوك. وهي قصيدة طويلة في أكثر من سبعمئة بيت، تُجمل القصيدة فكر ابن الفارض في الاتحاد. لو قُرأت شعرا فقط ستطربُ كثيرٌ من أبياتها وتُعجبُ معانيها، لكن لو عاملناها أنها تصريحٌ بفكرٍ ومعتقد فهي قصيدة كفريّة، وكما قال عنها الذهبي في سير أعلام النبلاء: “فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ القصيدَة صرِيح الاتِّحَاد الَّذِي لاَ حِيْلَة فِي وُجُوْدِه، فَمَا فِي العَالِمِ زَنْدَقَةٌ وَلاَ ضَلاَلٌ، اللَّهُمَّ أَلْهِمْنَا التَّقْوَى، وَأَعِذْنَا مِنَ الهَوَى، فَيَا أَئِمَّةَ الدِّيْنِ أَلاَ تَغضبُوْنَ للهِ؟! فَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ”.
توفي ابن الفارض سنة 632 هـ (1224م)، ودُفن في سفح جبل المقطم، وهو اليوم مُعظَّم من الكثير، وله مريدون لا يُحصون، يتغنَّون بشعره وقصائده.
وأقول مبدئيا إني لا أصدق كلَّ ما قرأته من قصص وأخبار عنه، ولا أراها إلا خرافات وأكاذيب لا تنطلي على من في كأس عقله ثُمالة أو حس سليم لا سيما أخبار الكرامات والمعجزات، وحتى ادِّعاء رؤيته النبي في المنام وطلبه أن يغير اسم القصيدة إلى نظم السلوك فلا يقع في نفسي موقعَ تصديق، وأنَّى لها سوى ذلك وهي مملوءة بالألفاظ التي تشي بالاتحاد والعياذ بالله. وبما أنَّ رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقٌّ، وأنَّ الشيطان لا يتمثَّل بصورته كما ورد في الحديث الشريف، وهذا ما يجعلني أكذِّب هذا الخبر ففيه من الكذب باسم رسول الله، اللهم إلا إنْ كانت بعض أبيات القصيدة لا تدل على الاتحاد وهذا ما لا أظنه ولا يستقيم عندي أمره. ونزَّه ابن الفارض في التائية شعره عن الحلولية فقال:
ولي من أتمِّ الرؤيتين إشارةٌ * تُنزَّهُ عن رأي الحلولِ عقيدتي
وفي الذكرِ ذكرُ اللبس ليس بُمنكرٍ * ولم أعدُ عن حُكمَيْ كتابٍ وسُنَّةِ
لكنه كذلك قال بالاتحاد (إذا سلّمنا بقول الشرح والمعاني الصوفية، وهو ما يعضد في أبيات كثيرة أخرى) في شعره:
فوصفي إذ لم تُدْعَ باثنين وصفُها * وهيئتُها إذ واحدٌ نحنُ هيئتي
وإن نطقتْ كنتُ المُناجي كذاك إن * قصصتُ حديثًا إنما هي قصَّتِ
بيد أنَّ تعاملي مع شعره تعاملٌ فنيٌّ جماليٌّ لا أكثر، أما ما يُسمى شعرٌ في العشق الإلهي فتعالى الله عن هذه الألفاظ والأوصاف وعن الشبيه والمثل “ليس كمثله شيء”، وأقرأه على أنَّه شعرٌ في العشق الأنثوي فهو أرضى لنفسي وأمتعُ لوجداني وأريح لخاطري وأبرأ لذمتي. ولعلي أفصِّل قليلا في هذا.
يقول من شرحَ شعر ابن الفارض إنَّ لأبياته، الكثير منها، معنًى صوفيًا، أي إنَّ للبيت الواحد عدَّة مستويات من التلَّقي والتورية، فالبيت الذي يقرأه القارئ ويَفهم معناه ليس بالضرورة هو ما قصده ابن الفارض، بل الحقيقة إنَّما هو كنَّى عن الذات الإلهية ثم بعد أن أشرع باب الكناية تعامل مع المُكنَّى بهيئته الجديدة، وكانت المرأة هي المخاطبة والمقصود الذات الإلهيّة العليّة. وهذا ما لا أستسيغه في مخاطبة الله عزَّ وجلَّ بما لا يليق بعظيم قدره وكبير سلطانه، وهنا أتقهقر قارئًا الأبيات في حب المرأة والعشق الأنثويّ. لا ينحصر خطاب الإله في أبياتِ الغزل حَسْبُ إنما يتعدَّاه إلى مواضيع كثيرة مختلفة، ولا يعني كلامي أنَّ كلَّ أبياته قبيحة حين تخلط بين الإلهي والبشري في خطاب واحد، ففيها أبيات رقيقة المعنى عذبة اللفظ سلسة الأسلوب، وإنْ عمد ابن الفارض في أبيات كثيرة إلى أسلوب وعرٍ كثرتْ فيه الجملة الاعتراضية والمعاني المركَّبة والتقديم والتأخير، فيُحمِّل البيت الواحد بشطريه فوقَ وسعه فتأتي الألفاظ محشودةً متراصةً لا فُسحة بينها، وتكاد تختنقُ غيرُ متاحٍ لها أن تتنفَّسَ.
يُخاطبُ ابن الفارض المرأة المقصودة والحبيبة في شعره، لكنها ليست أيَّ مرأة بل هي المرأة ذات الحسن الباهر والجمال الأخَّاذ المتمنِّعة المحصَّنة البعيدة المنال، التي نراها ونحلم بكلمة منها لا أكثر ولربما وجدنا أنفسنا أقل من أن ننال كلمة منها. فيقول:
حُبيّكُم في الناس أضحى مذهبي * وهواكم ديني وعَقْدُ ولائي
يا لائمي في حبِّ مَن مِن أجله * قد جدَّ بي وجدي وعزَّ عزائي
هلّا نهاكَ نُهاكَ عن لوم امرئ * لم يُلْفَ غيرَ مُنعَّمٍ بشقاءِ
لو تدرِ فيمَ عذلتني لعذرتني * خفِّضْ عليكَ وخلِّني وبلائي
وهي دائما ما تكون من خارج توقعاتنا وعوالم خيالنا فيزدادُ الولعُ بها ضراوة وتتلظى النيران في الصدر فتُحرقُ النفسَ والعقلَ والبدنَ في لهيب هواها. وعن هذا الانشداه بحالٍ لم يبلغه عقله عنها يقول:
وكنت أحسبُ أني قد وصلت إلى * أعلى وأغلى مقام بين أقوامي
حتى بدا لي مقام لي يكن أرَبي * ولم يمُرَّ بأفكاري وأوهامي
يجرُّ هذا المحبوب المتمنع البعيد متعًا تحول كلَّ شيء يخصُّه إلى لذة للعاشق، ويقلبُ القوانين الكونيّة في المضرِّ والنافع، فيقول:
وكلُّ أذًى في الحبِّ مِنكِ إذا بَدا * جَعَلتُ لهُ شُكري مكانَ شكيَّتي
نَعَمْ وتباريحُ الصَّبابةِ إنْ عَدَتْ * عليَّ، مِنَ النعماءِ، في الحُبِّ عُدَّتِ
ومِنكِ شقائي بَلْ بَلائي مِنَّةٌ * وفيكِ لِبَاسُ البؤسِ أسبَغُ نِعمَةِ
هذا الذوبان في المحبوب والانصهار في حبِّه أدخل العاشق حالًا من الوجد اللهَّاب والعشق العنيف أضاع منه نفسه وخلَّفها منساقة لمحبوبها وعبدًا لها. فيقول:
وادْعُني غير دعيّ عبدَها * نِعمَ ما أسمو به هذا السُّمي
إن تكنْ عبدًا لها تُعَدْ * خيرَ حُرٍّ لم يشُبْ دعواه لي
لكنه لم يكتفِ إذ أفرطَ العاشق في الانسياق وانفرطَ عقد ذاته، وولج في الخضوع البهيميّ، وهو شعورٌ مزيجٌ بين الحب والشهوة، يجعل صاحبه لا يعرفُ نفسه إلا بالانحطاط والدونيّة للمحبوب، بل في ذلك عظيم لذَّته واكتمالُ شرفه ورفيعُ متعته. فنراه يقول:
وإذا ما أحلَّت في هواها دمي ففي * ذرى العزِّ والعلياء قدري أحلَّتِ
لعَمْري وإن أتلفتُ عُمري بحبها * ربحتُ وإن أبْلتْ حشاي أبلَّتِ
ذللتُ لها في الحي حتى وجدتني * وأدنى منالٍ عندهم فوقَ همَّتي
وأخملني وهْنًا خضوعي لهم فلم * يروني هوانًا بي مَحلًّا لخدمتي
ومِن درجاتِ العزِّ أمسيتُ مُخلَّدًا * إلى دَرَكاتِ الذُّلِّ من بعد نحوتي
يبلغُ الوجدُ مبلغَه العظيم عند الشاعر، وهنا الشاعر ليس بالضرورة ابن الفارض بل الشاعر الذي تلبَّسه الناظمُ شعورًا ونطقًا مُبدعًا ذاتًا تتجسَّد عند النظم لتعبِّر عن مشاعرَ إنسانية ورغبات بشريّة، ويصير الاستخذاء والذُّل مكمنَ عواطفه وغاية حبِّه، لأن فيهما تحقيق الذات، فيقول:
فلو قيل من تهوى وصرَّحتُ باسمها * لقيلَ كنَّى أو مسَّهُ طيفُ جِنَّةِ
ولو عزَّ فيها الذُّلُّ ما لذَّ لي الهوى * ولم تُكُ لولا الحبُّ في الذُّلِّ عزَّتي
ويقول:
أشاهدُ معنى حُسنكم فيلذ لي * خضوعي لديكم في الهوى وتذللي
لكن لا يتوقف هنا إذ يصل في الانحطاط بذاته لأجل المحبوب إلى مرحلة الخضوع التعذيبي أو ما يعرف اليوم بالمازوخيّة حيث يستلذُّ بالتعذيب النفسي والجسدي كذلك، فيقول:
قَسَمًا بمن فيه أرى تعذيبه * عذْبًا وفي استذلاله استلذاذا
يتبعُ هذه المرحلة حالان الأول نفسيّ والآخر جسديّ، لا نرى عند الشاعر إلا النفسي متمثًلا في انتقال المحبوب من منزلته البشريّة إلى منزلة إلهيّة يُصبحُ فيها هو الإله المعبود والكائن الأسمى، ولا يتجلَّى المحبوب في هذه المنزلة إلا في عين العاشق، والإلوهية والعبادة هنا لا تعني بالضرورة ما توحيه ألفاظها من العبادة الشرعيّة للإله بإلوهيته وربوبيّته إنما هي حال وجدانيّة يُعظَّمُ فيها المحبوب فلا يُرى إلا أنَّه غيرُ بشريّ إجلالًا لقدره وتعظيمًا لمنزلته. فالعاشق لا يعبدُ المحبوب كما يعبدُ الإله بل يراه لا شبيهٌ بشريٌ له ولا مثيلٌ فيرفعه إلى بُعْدٍ سماويّ لا ينتمي العاشق إليه لأنه يرى نفسه لا يتساوى مع محبوبه. يقول:
وكفاني عِزًّا بحبكَ ذُلّي * وخضوعي ولستُ من أكفاكا
ويقول:
أهوى رشأً رُشَيْقَ القد حُلَي * قد حكَّمه الغرامُ والوجدُ عَلَيْ
إن قلتُ خذِ الروح يقل لي: عجبا * الروحُ لنا فهاتِ من عندكَ شيْ
كما لا يرى العاشق لغةً تناسب المحبوب إلا لغة عبادة الإله وما فيها من ألفاظ وأوصاف وصور، فيقول:
ولو خطرتْ لي في سواكِ إرادةٌ * على خاطري سهوًا قضيتُ بردَّتي
ويقول:
فلها الآن أصلي قبلتْ * ذاك مني وهي أرضى قبلتي
أما المرحلة الجسديّة فغير الواردة في شعره، التي يبلغها العاشق البهيميّ أو ذو الشهوة المنفلتة، وهي الرغبة في هتكِ المحبوب لجسده، ويصير الفاعل مفعولا به، مخالفًا قانون فطرة الأشياء، لأن في المخالفة، ومنح المحبوب كلَّ الصلاحيات في تغيير طبيعة الفطرة والجسد، أقصى اللذة التي يسعُ النفس والجسد الوصول إليها.
بيد أن العاشقَ لا يحسبُ هذا الحبَّ والخضوعَ ذُلًّا، ولا يرى بأسًا بذلك، على العكس تماما فلغة العاشق وعالمه لهما قوانينهما الخاصة، ولا يفهم المرء هذه القوانين حتى يكونَ جزءًا من عالمها، فالخضوع والذل والتذلل والانقياد والعبودية تتحول إلى مراتب يرتقي بها العاشق عند المحبوب وفي نفسه، وهذا الارتقاء هو الذي يُقرِّبه من ذاته الحقيقية وذات المحبوب، وهي ذات مطلقة متجاوزة لحدود الزمان والمكان، ذاتٌ فوق دنيويّة، تجعلُ جميعُ الأفعال في مستوى واحد ويغيب في حضرتها ولأجلها كلُّ مفهوم استخذائي للأفعال بغض النظر عن درجة انسحاق الكرامة الإنسانيّة وانمحاقها للمتلقِّي الخارجي. إنَّ حالة الوجد بين العاشق والمحبوب توحِّدهما فيرتقي المحبوب بانحطاط العاشق، لكنه ليس انحطاطًا إلا بمقابلته بالمحبوب لأنه في أصله ارتقاءٌ بالعاشق درجاتٍ أعلى فأعلى ليقترب من طرفِ المحبوب الأدنى، وهذه أسمى الأحوال وغاية الغايات للعاشق. أما ارتقاء المحبوب فهو انعتاقه من الناسوت واقترابه من اللاهوت، ونظرًا لرفعة المحبوب فإنَّ الفداء لا يكون منه لكن من العاشق الذي يُفني نفسه حتى يرتقي المحبوب. لا يُتركُ العاشقُ بلا جزاء أو مكافأة فبعد فنائه في سبيل المحبوب المُرتقي ينالُ مُتحدًا لمَّ الشمل معه، فتتحد الروحان ويجتمع الجسدان ويتلاقى البعيدان ويلتئمُ الفمان ويدخل الميل في المكحلة، ويبلغ حالهما المقام الأعلى عند الجِماع؛ حينها تختفي الفوارق ولا يكونان إلا واحدًا في لحظة أبدية. فيقول:
فوصفي إذ لم تُدْعَ باثنين وصفُها * وهيئتُها إذ واحدٌ نحنُ هيئتي
وإن نطقتْ كنتُ المُناجي كذاك إن * قصصتُ حديثًا إنما هي قصَّتِ
ويقول:
فلم تهوني ما لم تكنْ فيَّ فانيا * ولم تفْنَ ما لا تُجتلى فيكَ صورتي
ويقول:
أسائلها عني إذا ما لقيتها * ومن حيث أهدتْ لي هُداي أضلَّتِ
وأطلبها مني وعندي لم تزل * عجبتُ لها لي كيف عني استجنَّتِ
وما زلتُ في نفسي بها مترددًا * لنشوة حسي والمحاسنُ خمرتي
قد يَبعدُ المحبوبُ عن مريده راغبًا أو لعلِّة تاركًا العاشق مريضًا صريعًا في توقٍ أبديّ إليه، ويضحى أعزلَ في ميدان تعصفُ به الريح الهوجاء لا يستقرُّ له حال ولا يطيبُ له قرار ولا شفاء لمصابه إلا فيما يخصُّ المحبوب. يقول:
وُهمُ بقلبي إنْ تناءت دارُهم * عني وسُخطي في الهوى ورضائي
ويقول:
وإذا أذى ألمٍ ألمَّ بمُهجتي * فشذى أُعيشابِ الحجاز دوائي
ويقول:
وترابُه نَدِّي الذكيُّ وماؤه * وِرْدي الرَّويُّ، وفي ثراهُ ثرائي
نَدُّ: عود طيِّب الرائحة يُتبخَّرُ به.
ويقول:
لم أخشَ وأنت ساكنٌ أحشائي * إنْ أصبحَ عني كلُّ خِلٍّ نائي
ويقول:
أيا ساكني نجدٍ أما من رحمةٍ * لأسيرِ إلف لا يريدُ سراحا
هلا بعثتم للمَشوقِ تحيَّة * في طي صافية الريح رواحا
يحيا بها من كان يحسب هجركم * مزحًا ويعتقدُ المزاحَ مزاحا
ويقول:
أبدًا تسُحُّ وما تشحُّ جفونه * لجفا الأحبَّة وابلا ورذاذا
مَنَحَ السُّفوحَ سُفوحَ مَدْمَعه وقد * بَخَلَ الغمامُ به وجادَ وِجاذا
قال العوائدُ عندما أبصرنه * إن كان من قتلَ الغرامُ فهذا
جاذ: حفرت.
*
يكتنف هذه النوع من الحبِّ الخضوعي للمرأة رؤيتها على أتمّ وجوه الحسن والجمال، وهي رؤية فنيّة مثاليّة يطمحُ الشاعرُ ببصيرته إلى المثال الأسمى والمقام الأعلى في التصوير والتمثيل، ويكون جمال المحبوب مطلقًا يتجاوز كلَّ الحدود الحسيّة والعقلية ويكسر حواجز المنطق، لأنه لا يصل إلى المقام الأجلّ في انعتاقه من ذاته والذوبان في المحبوب إلا إذا انتشر بهاؤه الفيَّاض وأغرقه، فيضحى الوجود بأكلمه صورةً من صور حُسنه، وساعتها حسبُ ينال منه كفايته ويسعى إلى وصفه بأوصاف لا بشرية، فما جماله إلا انعكاس للجمال المطلق والأصل الذي ينبع منه كلُّ جمال. فيقول:
أشاهدُ معنى حُسنكم فيلذ لي * خضوعي لديكم في الهوى وتذللي
ويقول:
كملت محاسنه فلو أهدى السنا * للبدر عند تمامه لم يُخسَفِ
وعلى تفنن واصفيه بحُسنه * يفنى الزمان وفيه ما لم يُوصفِ
ويقول:
عيني جرحت وجنته بالنظر * من رقتها فانظرْ لحسن النظر
لم أجنِ وقد جنيتُ ورد الخَفَر * إلا لترى كيف انشقاقُ القمر
ويقول:
وصرّح بإطلاق الجمال ولا تقل * بتقييده ميلا لزخرفِ زينةِ
فكل مليحٍ حُسنه من جمالها * معارٌ له بل حُسن كل مليحةِ
بها قيس لبنى هامَ بل كل عاشق * كمجنون ليلى أو كُثيّر عَزَّةِ
فكلٌ صبا منهم إلى وصف لَبْسها * بصورة حسن لاح في حسن صورةِ
*
في الختام ما موضع هذا الحب في سُلَّمِ الحبِّ، ومن يبلغُ هذه الدرجة في العشق، وأيُّ امرأة جديرةٌ بهذه المنزلة؟ هذا الحب الخضوعيّ أشبه ما يكون سبيلًا إلى نشوة الجِماع أكثر منه شعورًا عميقًا في النفس، لكنه إنْ كان حقيقيًا أصيلًا في النفس فهو ينتمي إلى عالمٍ مثاليّ مطلقٍ، الرجلُ والمرأةُ فيه غير بشريين في نفسيهما لا جسديهما. وهذا ليس بالأمر الغريب أو الشاذ فتمظهرات هذا الضرب من الحبِّ والعَلاقة بين الذكر والأنثى يتراءى لنا في أنماط الخضوع والسيطرة والمازوخيّة والساديّة، وفي الغالب تُمنحُ المرأة فيه اليد العُليا لا لشيء أكثر من مخالفة السائد وقلبَ الأدوار ومخالفة الفطرة ليجعلهما يستلذان بالجديد وغير الشائع، فالنفس تتوقُ، ولو في سرِّها، إلى غير المطروق والمختلف، وتحبُّ ممارسته في السرِّ وإنْ شتمته في العلن.



