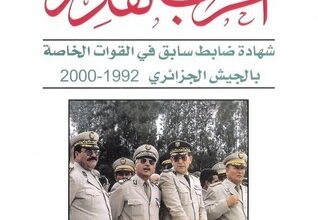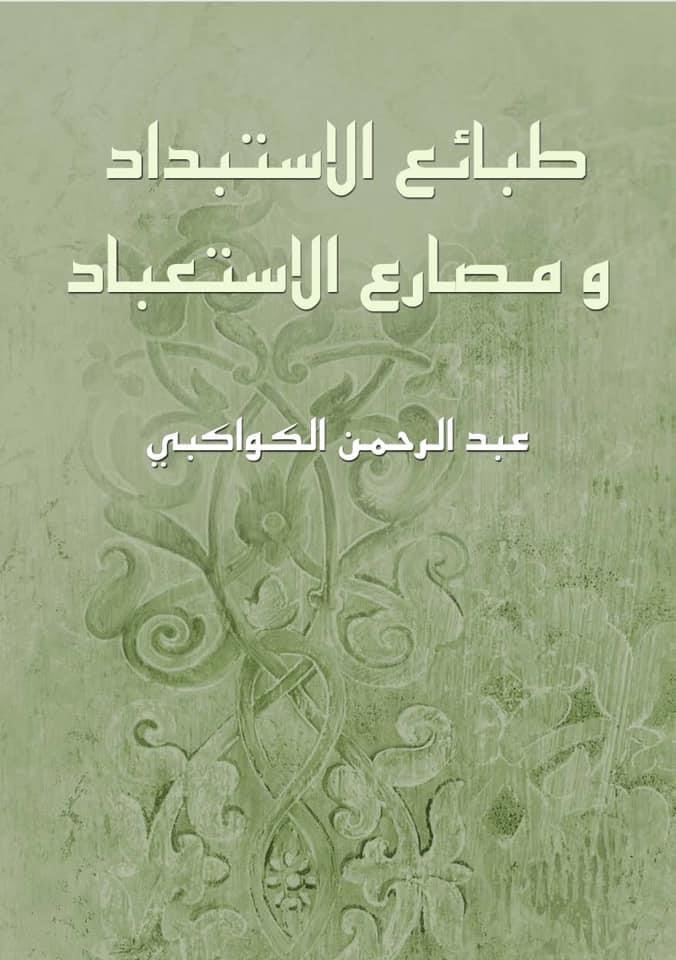
عبد الرحمن الكواكبي (1855-1902) مفكر عربي وأحد قادة النهضة العربية، ولد في حلب لأسرة عربية قديمة، ذات علم ودين، فقد قيل إنَّ والديه يعودان بالنسب إلى العائلة العلوية الشريفة، وكان والده أحمد بهائي مدير المدرسة الكواكبية في حلب. كفل الكواكبي خالته صفية آل النقيب بعد وفاة والدته عفيفة، فدرس في أنطاكيا بعد أن انتقل إليها رفقتها، فتعلم القراءة والكتابة والتركية وحفظ من القرآن، ليعود بعدها إلى حلب ليكمل دراسته، ثم انتقل إلى أنطاكيا مجددا ليدرس العلوم، كانت حياته حافلة بالمناصب التي تقلّدها لأجل أن تغري السلطة لسانه فيداهنها لكنه أبى إلا أن يكون صوت الناس مجاهرا بأخطاء الحكومة الأمر الذي عُرِّضَ بسببه إلى مشاكل مع السلطات العثمانية والولاة وصلت إلى حبسه والحكم عليه بالإعدام لكن استطاع الخلاص منهما مرَّة بالدفاع عن نفسه وكشف تزوير الوثائق الكيدية ومرة بالمظاهرات التي خرج بها إلى أهل حلب للإفراج عنها، لينتهي به المطاف هاربا إلى مصر في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 1899، ونشر فيها أهم مؤلفاته (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) في مقالات في صحيفة “المؤيد” في حينها “طبائع الاستعباد” الكتاب الذي كان كما مرجح السبب في اغتياله بفنجان قهوة مسموم في مقهى “يلدز” قرب “حديقة الأزبكية” في القاهرة.
وكان لموت صداه فقد رثاه الأدباء والشعراء مثل مصطفى صادق الرفاعي وحافظ إبراهيم الذي قال في بيتين:
هنا رجل الدنيا، هنا مهبط التقى هنا خير مظلوم، هنا خير كاتبِ
قفوا، واقرؤوا (أم الكتاب)، وسلّموا عليه، فهذا القبر قبر الكواكبي
من مؤلفاته الأخرى: أم القرى، والعظمة لله، وصحائف قريش.
يقول في مقدمة كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد:
“في زيارتي هذه لمصر، نشرت في أشهر جرائدها (المؤيد كما ذكرت أعلاه) بعض مقالات سياسية تحت عنوانات: الاستبداد، ما هو الاستبداد وما تأثيره على الدين، على العلم، على التربية، على الأخلاق، على المجد، على المال… إلى غير ذلك. ثم في زيارتي مصر ثانية أجبت تكليف بعض الشبيبة، فوسعت تلك المباحث خصوصا في الاجتماعيات كالتربية والأخلاق، وأضفت إليها طرائق التخلص من الاستبداد، ونشرت ذلك في كتاب سميته (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) وجعلته هدية مني للناشئة العربية المباركة الأبية المعقودة آمال الأمة بيمن نواصيهم، ولا غرو فلا شباب إلا بالشباب. ثم في زيارتي هذه وهي الثالثة (الأخيرة التي اغتيل فيها عام 1902)، وجدت الكتاب قد نفد في برهة قليلة فأحببت أن أعيد النظر وأزيده زيدا مما درسته فضبطته، أو ما اقتبسته وطبقته. وقد صرفت في هذا السبيل عمرا عزيزا وعناءً غير قليل… وأنا لا أقصد في مباحثي ظالما بعنيه، ولا حكومة أو أمة مخصصة، إنما أردت بيان طبائع الاستبداد وما يفعل، وتشخيص مصارع الاستعباد وما يقضيه ويمضيه على ذويه… ولي هناك قصد آخر وهو التنبيه لمورد الداء الدفين، عسى أن يعرف الذين قضوا نحبهم أنهم هم المتسببون لما حل بهم، فلا يعتبون على الأغيار ولا على الأقدار، إنما يعتبون على الجهل وفقد الهمم والتواكل… وعسى الذين فيهم بقية رمق من الحياة يستدركون شأنهم قبل الممات”.
هذا الكتاب وإن كان حجمه صغيرا فعلمه غزير وثقله كالصخور الجلاميد، فكأن كلماته معاولَ يهدم بها قصور الطغاة ويرميهم بطير فكره الأبابيل، فيخلفهم هشيما محتضرا لا تنفذ أكاذيبهم وأساليبهم بعدها إلا على عُمي البصائر والبصر، أعزة على ذويهم أذلة على المستبدين ممن ملكوا البلاد والعباد فما أقاموا شرعا ولا حفظوا عرفا ولا اتبعوا حكم إله أو إنسان ولم يروا غير طريق الغي والشيطان، وما أكثرهم في بلادنا العربية، فلا الحياة حياة كريمة ولا الموت موت شريف. عمل الكواكبي في كتابه هذا على تفصيل موضوع الاستبداد وتوزيعه في فصول ومقالات تنوعت بعد تعريف الاستبداد لغة وعرفا على تأثير الاستبداد وأسبابه ونتائجه في: الدين، والعلم، والمجد، والمال، والأخلاق، والتربية، والترقي، وكيفية التخلص منه.
يجد القارئ النَبِه الفَطِن في هذه المباحث الثمانية علة العلل التي نعاني منها منذ بواكير القرن الماضي، وتفاقمت سوءا في العقود الأخيرة، فأينما تولي وجهك فوق هذه الأرض تصطدم بحاكم سوء طاغية أو حكومة فُجر باغية، لا يسلم فيها شريف من الذلة، ولا عزيز من المهانة، ولا غني من ذل السؤال، ولا عالم من قهر الإلجام، فالإرادة مسلوبة، والفكر مُعتقل، والحرية مُقيدة، وإن نادى بعضهم بامتلاكهم هذا، فما هي إلا نشوة سكران أو أحلام عبدٍ في الأصفاد، رضي بالقليل الذي تأباه الحيوانات، وتموت تحت شمسه النباتات. فهذا هو الحال من مشرق يطل على الخليج إلى مغرب مطل على المحيط، ولا تفاوت إلا في دركات السوء، ولا فضل في هذا إلا في أذهان البُله والمجّان من خدم ونعال السلطان. يخلص الكواكبي إلى علة العلل محددا تفاصيلها وكشف السبيل إلى معرفة الداء وكيفية الحصول على الدواء، فيقول لا يعود تراجعنا إلى جهل منتشر بين الناس، ولا ابتعاد عن الدين وتطبيقاته، ولا الاختلاف في الآراء والأفكار، بل في الاستبداد السياسي للطَغام الحاكمة فإن ملكوا الحكم أفسدوا الدين وأهله، واضمحلَّ بفضلهم العلم والعلماء، وشاعت الأخلاق الرديئة فيقول “أسير الاستبداد لا نظام في حياته، فلا نظام في أخلاقه، قد يصبح غنيا فيضحى شجاعا كريما، وقد يمسي فقيرا فيبيت جبان خسيسا”، ويشيع المجد الزائف المتوج بالظلم والطغيان، ويكثر المطبلون اللاهجون باسم ذاك وذاك فيما أسماه التمجد، وأما المال فيصفه بأنه دين وشرف وحياة الاستبداد، “فتكثر رؤوس الأموال في عهد الحكومات المستبدة فيسهل تحصيل الثروة بالسرقة من بيت المال، وبالتعدي على الحقوق العامة، وبغصب ما في أيدي الضعفاء”، وأما التربية فلا تربية تحت ظل الاستبداد فيقول: “الاستبداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحيل والخداع والنفاق والتذلل، وإلى مراغمة الحس وإماتة النفس ونبذ الجدّ وترك العمل، إلى آخره. وينتج من ذلك أن الاستبداد المشؤوم يتولى بطبعه تربية الناس على الخصال الملعونة، وأما الترقي فلا ترقي في عهد الانحطاط، وأي انحطاط أكبر من حكومة مستبدة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، ولا شيء فيها إلا ما يهوى ويشتهي السلطان.
والمبحث الأخير من كتابه فإن يشمل طرق التخلص من الاستبداد والتي كان من أبرزها نشر العلم بين الناس وتعريفها بعدوها الحقيقي، والشعور بآلام الأمة كاملة الغني بالفقير، والقوي بالضعيف، والعزيز بالذليل، ومقاومة الاستبداد بالتدرج واللين وإلا فإننا نستبدل طاغية جديد بالطاغية القديم، ثم والأهم تهيئ البديل، وبماذا سنستبدل حكومة الاستبداد.